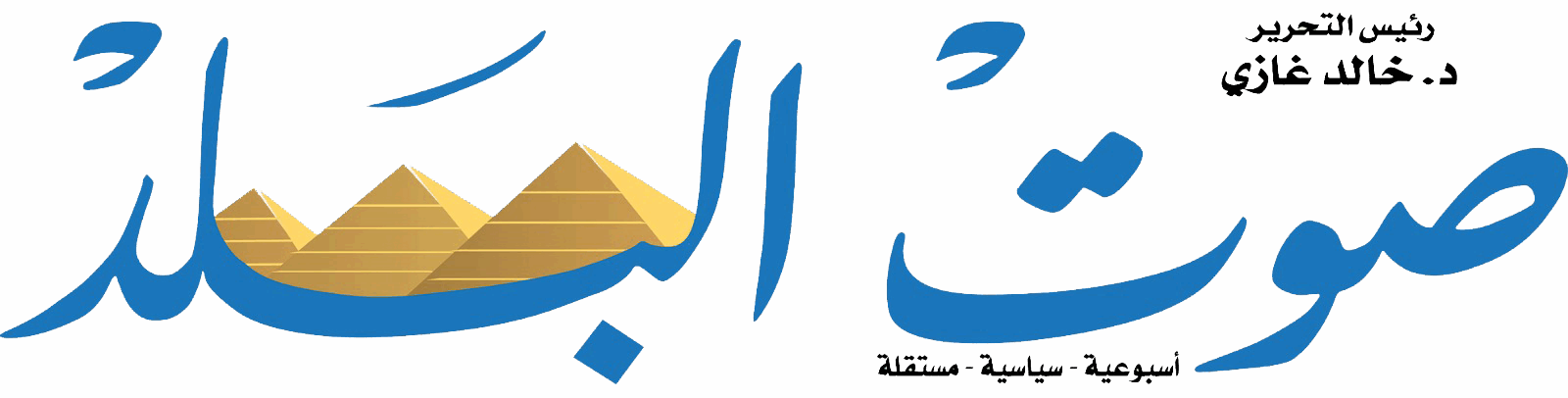في زمن تاهت فيه المعاني الحقيقية للشجاعة، خرج من قرية صغيرة بمحافظة الدقهلية بطل حقيقي، لم يدرس في أكاديميات الدفاع، ولم يحمل رُتبًا أو أوسمة، بل كان سائق بسيطا يدعى خالد محمد شوقي عبدالعال. رجل عادي في عيون الناس، لكنه كان يحمل في قلبه بطولة تُقارع أعظم المواقف، تعيد الأذهان قصص التضحية التي نحكيها لأطفالنا، ولا نظن يومًا أنها ستحدث أمام أعيننا.
المشهد لم يكن جزءًا من فيلم درامي، ولا مشهدا تمثيليًا على شاشات السينما. بل كان واقعا اشتعل فيه الخطر حرفيا، عندما توقف خالد بشاحنته المحملة بالوقود في إحدى محطات البنزين بمدينة العاشر من رمضان، في يوم شديد الحرارة. لحظة واحدة فقط كانت كافية لتقلب كل شيء؛ شرارة غامضة أو ضغط حراري فوق الاحتمال، اندلعت النيران فجأة في خزان الوقود ، وتحولت السيارة إلى قنبلة موقوتة، تهدد بتفجير المحطة وما حولها من أرواح وأملاك.
وسط صراخ الناس وركض العاملين في المحطة، وبين دهشة العيون التي تجمدت من الخوف، تحرك خالد وحده في الاتجاه المعاكس. لم يركض مستعدا كما فعل الجميع، بل قفز إلى مقعد القيادة، و النيران تحيط بجسده، وهو يدرك تمامًا أن هذه اللحظة قد تكون الأخيرة في حياته. لكنه لم يفكر في نفسه، بل في المحطة، وفي أرواح الناس الذين قد يُفنيهم انفجار واحد.
قاد خالد الشاحنة المشتعلة، بعزيمة رجل لم يعرف الخوف، وأخرجها من المحطة إلى الشارع، بعيدًا عن الخطر. لم ينظر للخلف، ولم ينتظر تصفيقًا أو مديحًا، فقط فعل ما شعر أنه الصواب، احتضن الخطر بكل ما فيه من ألم واحتراق. ولأن البطولات الحقيقية لا تكون بلا ثمن، فقد طالته النيران، ابتلع الحريق جسده النحيل، يصاب بحروق عميقة نقل على إثرها إلى مستشفى بلبيس، ومنها إلى مستشفى أهل مصر للحروق، حيث ظل يصارع الألم في صمت، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
رحل خالد، لكن قصته لم ترحل. بل تحولت إلى أيقونة بطولية تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل، تحكيها الألسنة بإجلال وفخر. بطل شعبي خرج من عباءة البسطاء، وترك خلفه درسا إنسانيا نادرا: أن البطولة لا تحتاج إلى أضواء، بل إلى قلب حي، وضمير لا يعرف التخاذل.
اليوم، تتساءل مصر: هل سنترك هذه القصة تمر كحادث عابر؟ هل سنكتفي بنشر الخبر ثم نطوي الصفحة؟ الإجابة لا يجب أن تكون بالكلمات فقط، بل بالفعل. خالد شوقي يستحق أكثر من الرثاء. يستحق أن تُخلد قصته في مناهج التعليم، أن تطلق اسمه على مدرسة أو شارع في قريته، أن يجد أطفاله الدعم والرعاية الكاملة، وأن تكون بطولته مصدر إلهام للأجيال القادمة.
المستقبل لا يكتب فقط بالسياسة أو الاقتصاد، بل يبنى على القيم التي تجسد في مواقف كتلك. فإذا أردنا لأبنائنا أن يعرفوا معنى الشجاعة، فليكن خالد نموذجا. وإذا أردنا أن نعلم شبابنا معنى المسؤولية والتضحية، فليكن اسمه حاضرا في كل حصة، وكل سطر، وكل لوحة شرف.
الأبطال لا يموتون، بل يرحلون بأجسادهم فقط، وتظل أرواحهم حية بيننا، تنير الطريق وتلهم العقول. وهكذا سيبقى خالد، رمزا للبسالة في وجه الموت، صوتا صامتا يقول لكل من يهرب من المواقف الصعبة: كن شجاعا، كما كان خالد.
وإذا كانت الدولة اليوم تبحث عن رموز تجدد بها خطابها المجتمعي، وتعيد الثقة في القيم الوطنية، فلن تجد خيرًا من هذا السائق البسيط، الذي كتب اسمه بدمه في سجل الخالدين، دون أن يطلب شيئًا سوى إنقاذ أرواح لا يعرف أصحابها.
هكذا تصنع الأساطير، لا بكثرة الأحاديث، بل بلحظة واحدة تكشف فيها المعادن، تفرز فيها القلوب. لحظة لا تُمتحن فيها الشجاعة بالكلام، بل بالفعل… وخالد فعل