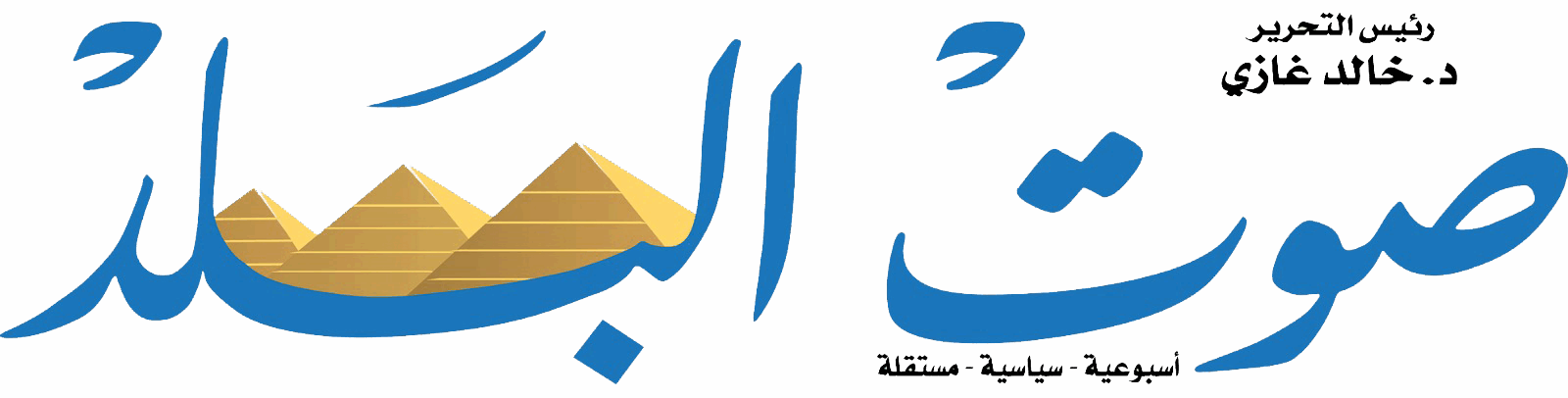سماء تشرق بالحرية بعد عقود من حكم الحديد والنار بقيادة عائلة الأسد.. هكذا عمّت أفراح الشارع السوري في بلاد أنهكتها الحرب وقيود الاستبداد، فضلّ الأمل طريقه لقلوب الشباب بعد أن أضحى الآلاف منهم بين لاجيء ومعتقل.
لم ينس أحد الأطفال الذين قضوا غرقًا في عرض البحر أو تجمدًا في خيام اللجوء. لم تنس ذاكرة العرب بلاد تم قصفها بوحشية عقابا على الثورة، ثم تحوّلت لغنيمة تتناوشها القوى الكبرى وعملاؤها.. اختارت الأديبة السورية شادية الأتاسي أن تلجأ لسويسرا، ولكن جمالها لم يخف من نفسها أصوات الصواريخ ونيران القذائف ومشاهد الرعب المعششة في رأسها.. وهرعت للكتابة ملاذا يعوضها هذا الانكسار المريع.. وأصبح مشروعها الإبداعي سيرة للإنسان السوري متقاطعة مع الحرب والحياة..
في السطور التالية تحدثنا “الأتاسي” عن الكتابة حين تصبح نجاة، عن بيتها القديم في دمشق وحياتها في الغربة.. وعن حق السوريين في الفرح بالنهار بعد نفق مظلم طويل.
تكشف الحرب في كتاباتك أقبح وجوه البشرية.. فكيف انعكست عليكِ كمبدعة عاصرت ثورة الياسمين؟
لا يمكن لمن يتخذ من الكتابة سلاحًا ناعما البقاء في معزل، تأثير الثورة والحرب كان عميقًا، ليس فقط في التكوين الوجداني، بقدر ماهو في التأثير الفكري والثقافي، ولقد فعلتُ كما فعل أغلب الكتّاب، حملت رحالي، وجلست على رصيف الغربة، أرنو إلى الوطن المنهوب من خلف الحدود وأكتب عن سورية والسوريين .
في مجموعتي الأولى “أنا التي لم أعد هناك” قلت على لسان الراوية: الموت في بلدي لا يشبه الموت في بلد آخر، يخلع كفنه فجأة ، ويرتدي ثوب البلد، انكسار البلد، هوانه وتمزقه ، بؤسه وغضبه ، شروخه وانقساماته.
رواية “تانغو الغرام” أيضًا هي رواية الحرب والحب المبتور والفقد. تسرد الرواية، إمرأة عادية تحب وتُحب، يوميات الحرب والفظائع من خلال رصد تداعيات الحرب المندلعة في سوريا، وآثارها المباشرة وغير المباشرة، وما أحدثته من عطب في بناها النفسية، الأمر الذي كانت له نتائجه المدمرة على كل منها. وهي لا تقف عند حدود التدمير الخارجي المباشر للمكان، بل تتعدى ذلك إلى التدمير الداخلي غير المباشر للإنسان.
نكتشف أنه “في الحرب لم تعد أنت، تفاجأ بأشياء كنت تحسبها ثابتة، يدهشك أن تدرك أنها تتغير، وكم هي الآنا داخلك هشة، سهل اقتلاعها، أمام هجوم عاصف لتحولات كبرى، فرضت نفسها بقوة. الحرب وضعتنا أمام ذواتنا، قالت لنا بجلاء: هذا أنتم ، تعرفوا على أنتم .
“إعصار عذب” تتجلى فيها تداعيات التغريبة السورية.. حدثينا عن تداعي تلك التيمة إليك؟
في هذه الرواية تابعت مشروعي الروائي ضمن سردية الحكاية السورية المعاصرة، عن هذا الذي خرج مطارداً يتابع رحلته في المنافي، وما أفرزته المحنة السورية من عالم ممسوس بإشكاليات معقدة.
بدأت الرحلة من حي المهاجرين الدمشقي وانتهت على الرصيف الضيق الموازي لبحيرة ليمان السويسرية. هي حكاية “سليمى” التي عاشت محنة الاغتراب عن الوطن، والبحث عن وطن بديل.ليأتي بحثها، قرين البحث عن ذاتها في بلد تحاول أن تنتمي إليه، مع مواجهة تحدي حياة وثقافة ولغة مختلفة، وإذا تجاوزت ذلك فهل يمكن تجاهل مسألة الحنين؟ إنها محنة أبدية تلازم الغريب الذي انتقل إلى فضاء غير فضاءه. في مدينة ساحرة الجمال.
تقول سليمى في الرواية …
“بكيت كثيراً وأنا أمشي على ضفة البحيرة، بكيت بقلب ثقيل ، وأنا أتأمل هذا الجمال الثابت المعزول، أدركت مدى الكسر الذي شجّ روحي، وأنا أبحث عن أماني في وطن بديل. وأنا كإمرأة متوترة المزاج، كان مبكراًعليّ،أن أقرأ مزاج المدينة البطيء. إيقاعه كان ثقيلاً وعميقاً، ينسحب إلى الداخل، إلى حيث النأي والبرد والوحدة”.
يقول عازف الكمنجة الذي ركب البحر فرارا من الموت: ولقد هربت، كما فعل أغلب السوريين، ربما هو نوع من التشبث بالحياة، أو الرغبة بالموت في مكان آخر بدلاً من التعفن بعتمة المعتقل، فمن الأفضل أن أموت موتاً عاطفياً يستحق الرثاء، أو قد يحمل معنى البطولة”.
كيف تأثرتِ بسقوط نظام بشار الأسد على نحوٍ غير متوقع؟
تساءلت أولًا: هل هو حلم؟ كان هذا رد فعل الجميع الأول. غير مصدقين، أن البلاد أصبحت حرة، و الكابوس المفزع الذي كسر روح الإنسان السوري لعقود طويلة، وتركه وحيدا ً يحمل صخرته على كتفه، مسلوب الحرية والكرامة قد انتهى، والديكتاتور فرّ إلى غير رجعة .
صحيح أن هناك جدل و حذر،لا يمكن لأحد تجاهل الخلفية الدينية المتشددة لهيئة تحرير الشام، وهذا التخوف أعتبره أمرًا صحيا ومحقًا؛ لقد عانى الشعب السوري الكثير، وعليه أن يتأنى ولايقع في فخٍ آخر.
لكن ما تحقق من إيجابيات لا يمكن له إلا أن يهز حالة الجدل والخوف هذه، وأولها وأهمها سقوط نظام شرس فقدنا الأمل بإزاحته، وأن هذا السقوط تم بشكل أبيض ناعم سلس، دون إراقة دماء. وأن القادمين معظمهم من أبناء البلد الذين هجّرهم النظام.
الموضوع السوري ليس سهلاً، سورية خليط من موزاييك متعدد العرق والقومية والإثنية، يحمل حضارة موغلة في التاريخ، كانت على مر العصور تحمل مبادىء الإسلام المعتدل، لا يمكن لها أن تكون كابول ثانية، والهيئة لابد أنها أدركت هذا الأمر جيداً، قدمت التطمينات فور دخولها، وسارعت إلى اقامة حكومة مؤقتة لضبط الأمن، وقالت على لسان قائدها سورية لن تكون أفغانستان اخرى.
مرحلة انتقالية
وهل تثقفين في وعود قائد المرحلة الانتقالية بدولة حرة لكل السوريين؟
قد لا أملك رفاهية تقييم وعود “الشرع”، أنا مواطنة عادية، والوقت مازال مبكراً. لكن أؤمن بحتمية التغيير، الحتّ الدؤوب لابد أن يهز الأبواب المغلقة، لقد قدم الشرع الكثير من التطمينات والوعود، ولقد نظر اليها السوريين بكثير من الأمل والارتياح، هذا صحيح وجميل ، لكن هل يملك الشرع العصا السحرية لتغيير تراكم واقع متجذر من خمسين عاما؟ إن لم يكن بمشاركة ووقوف كل المكونات السورية التي قامت بثورتها من العام ٢٠١١ لبناء سورية الجديدة. علينا أن ننتظر. ولن تكون سوريا غير دولة حرة ديمقراطية.
كيف رأيت مشهد تحطيم السجون والتماثيل الأيقونية لحقبة بشار؟
أعتقد أن من شهد عملية فتح وتحرير السجون، على مرأى من العالم كله، لم يستطع أن يملك دموعه، وهو يرى الأبواب المصفحة تفتح وآلاف المعتقلين تخرج منها، مذهولة ، غير مصدقة، وقد فاجأها ضوء الحرية . ما تكشف عنه هذا المشهد من حكايات رعب وقهر وقذارة، تكفي وحدها لأن تقوم مائة ثورة ضد هذا النظام. سجون سرية مظلمة تحت الأرض، رجال فقدوا شبابهم و ذاكرتهم من التعذيب، أمهات لا يعرفن فيما إذا كان أولادهم المعتقلين مازالوا على قيد الحياة، مهاجع ضيقة مظلمة أكلتها الرطوبة.
حدثينا عن بيتك الدمشقي الذي غادرته.. هل لا يزال حنينك لمرابع الذكريات هناك؟
قدر لي لأسباب إنسانية أن أزور الوطن . بعد ثمانية سنوات من الغياب، دخلت دمشق ليلا ً قادمة من مطار بيروت بسيارة تكسي، عتمة كثيفة وسكون مريب كان يخيم على الحي الذي كان يوماً يضج بالحياة، رحت أحدق بعيون زائغة في مداخل الأبنية العالية، أبحث بحيرة عن بيتي بينها، هتفت بالسائق مرات عدة أن يتوقف. تغير كل شيء، المدخل. السكان، الحديقة.الإضاءة. ومن حسن الحظ أني وجدت قريبي ينتظرني قلقاً على بعد بضعة أمتار. صعدنا الدرج، قرعنا الجرس، فتح أقاربي الذين سكنوا البيت بعدي الباب، دعوني مرحبين إلى الدخول، لبرهة ترددت، هل كان علي أن أخلع حذائي؟ ثم إلى أي غرفة أتجه وأين أضع حقائبي؟ لم أكن صاحبة البيت ، كنت ضيفة، ضيفة غريبة في بيتي.