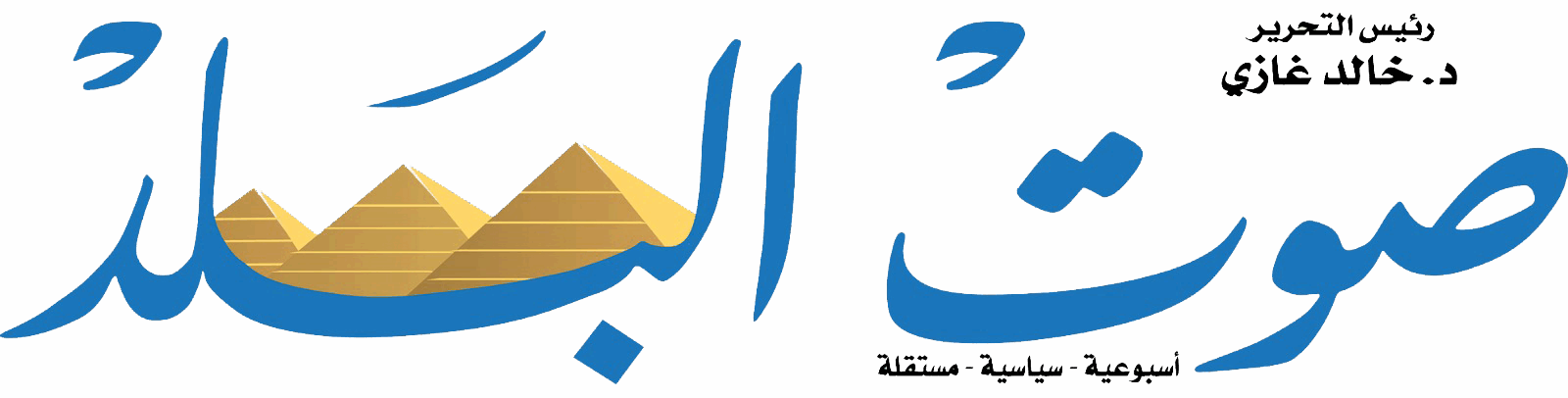الكاتب محمد الفخراني روائي مصري تميز مشروعه الأدبي بثيمة رئيسية تدور في فلكها رواياته وهي الإنسانية والانتصار للإنسان. تتجلى دومًا في أعماله ثيمة رفض الحرب والانتصار للإنسانية، وأحيانًا تكون نصوصًا كونية تتميز بالتعميم، وتنضح بالأفكار الفلسفية. بالرغم من قسوة الواقع، إلا أنه يبدو متفائلًا بالإنسان، فدائمًا ما ينتصر للإنسانية عبر الفن والخيال. الفانتازيا والتأسيس الأسطوري يمثلان حجر أساس في أعماله، مع شغف واضح بالعالم والطبيعة والإرادة لتغيير الواقع عبر تصوير الخيال بملامح يوتوبية يفتقدها الواقع كثيرًا، ولكنه يرجوها ويأملها.
حصل الفخراني على عدة جوائز، منها: جائزة يوسف إدريس في القصة القصيرة في مصر والعالم العربي عام 2012 عن مجموعة “قصص تلعب مع العالم”، وجائزة “معهد العالم العربي” في باريس عن رواية “فاصل للدهشة” عام 2014، والتي تُرجمت إلى اللغة الفرنسية، وأيضًا جائزة “معرض القاهرة الدولي للكتاب” في دورته الـ (55) مطلع العام الجاري عن رواية “غذاء في بيت الطباخة”.
وحول روايته الأخيرة “حدث في شارعي المفضل”، أجرت معه “صوت البلد” حوارًا كشف فيه عن الكثير من الأفكار والإجابات التي ترد على تساؤلات القارئ حول الرواية التي تميزت بالغموض والتساؤلات الفلسفية، متخذةً من قضية الأرض ثيمة رئيسية، بجانب الإنسانية ونبذ الحرب، من خلال أحداث غامضة استعرضها الكاتب بلغة ناعمة ومريحة ليغمر القلب شعور غني بالسلام أثناء قراءة الرواية رغم ما يعرضه الكاتب من مآسي، في ظل تسليم مريح للقدر.. وإلى نص الحوار..
لماذا اخترت أن تكون بطلة رواية “حدث في شارعي المفضل” امرأة؟
بالأساس لم يخطر ببالي أيّ اختيار آخر، لم أرها إلّا امرأة شابة في العشرينات، مثلما ظهرت في الرواية، وهذا يحمل بداخله كل الأسباب، أو أنه أقوى سبب: ببساطة لم أفكر في اختيار آخر.
يظن القارئ طوال الرواية أن الرسام الموهوب هو زوج البطلة ليتضح في آخر سطور الرواية أنه أخيها الأصغر! فما الهدف من التغميض في شخصيته إلى هذا الحد؟
كان من السهل أن يكونا حبيبين أو زوجين، لكن الكثير من قصص النجاة سواء في السينما والأدب بها الزوجان أو الحبيبان. في الوقت نفسه فإن القارئ طوال الرواية سيعتبرهما حبيبين، ثم يكتشف أنهما أخت وأخيها في السطور الأخيرة. إذن، فقد حصل على قصة الحب بالفعل، ثم يظهر شيء كأنه مفاجأة في النهاية. وكان من الممكن كشف أنهما أخ وأخته من البداية، لكن ربما هذا ليكون أقل فنيًّا.
البيت الطيني هو آخر ما تبقى من الأرض بجانب مساحة زراعية صغيرة ملحقة به.. هل اخترت أن يكون ما تبقى من الأرض هو بيت طيني ريفي بسيط وبدائي في مقتنياته لتعلن رفضك للتطور وما تبعه من إلحاق الضرر بكوكب الأرض والانحياز للبدائية وبراءة الطبيعة؟
ليس رفضًا للتطور، ولكن هذا البيت يُمثِّل عودة أو بداية جديدة للأرض، فالمنطق أن يكون طينيًّا، ومن جسم الأرض الطيني، كما أنه كآخر بيت على الأرض فالمتوقّع أو الطبيعي أن يكون طينيًّا، وحتى تقنيًّا وفنيًّا، لو أن البيت داخل الرواية كان عصريًّا فهذا يتطلّب أشياء عصرية مثل الكهرباء وغيره، وهذا لم يكن متاحًا لأن الأرض انتهت، وكذلك العالم، فلن يكون هناك مجال لحياة عصرية، إذن الحل تقنيًّا وفنيًّا هو البيت الطيني.
وددت كثيرًا أن أعرف المغزى وراء ظهور الأم الستينية ذات رائحة الورد، والمعنى المراد من إلقائها بنفسها في الانهيار بعد هروب حافل دون خوف ودون انتظار؟
الأم الستينيَّة شخصية بها شيء من الدهشة تظهر داخل الرواية في مشهد واحد، أنا أحب ظهور شخصيات في أعمالي يكون لها مشهد واحد، لكنها لا تُنسى. أمّا عن المغزى من كونها تُلقي نفسها إلى عمق الأرض، فهذا ليس كتضحية أو فداء للشخصيتين في الرواية، إنما لأن هذا يناسب شخصيتها المدشة النزقة داخل الرواية. وكذلك لأن المضمون الذي نفهمه داخل الرواية أن الأرض لا تأخذ أحدًا لتقتله، إنما هي وكأنها تحتفظ بكل شيء بداخلها، هي فقط بطريقة ما، تنبّهنا – نحن البشر – للاهتمام بها، وأن نكون أكثر لطفًا معها، وعناية بها.
فكرة التنقل في عمر البطلة.. هل استخدمتها لتعميم التجربة وشمول كل البشر؟ أم هناك مغزى آخر وراءها؟
إن تتنقّل البطلة في عمرها، هي لعبة فنية أحبها في الرواية، تعطي حيوية للنص الأدبي، فهنا لدينا شخصية واحدة ومكان واحد، ومن المهم ابتكار تقنيات فنية تخلق الحيوية داخل النص، ومنها انتقال الشخصية في عمرها. كما أن الفكرة ترفع سقف الممكن، وهذا أحد ما يفعله الأدب، نزع السقف، لا سقف، ثم أنّه من المنطقي أن يحدث هذا التنقُّل، أي أنه من المنطقي في الفكرة والحالة التي تطرحها الرواية : غياب الأرض، واختلاط الزمن، لم يعُد هناك زمن ولا وقت، وهذا ما يمكن استغلاله فنيًّا.
سرد الرواية تم عبر ضمير المتكلم “الأنا” وتقنية تيار الوعي، فسطر رؤية أحادية للأمور.. هل هناك تعارض بين ذلك والثيمة الرئيسية للرواية وهي تعميم قضية الأرض؟
السرد بضمير المتكلم يضع القارئ موضع الشخصية الساردة، كما أنها داخل الرواية كانت تُوجِّه بعض سردها إلى الجميع، البشر المُفترَضين، وهو ما يعطي صوتًا سرديًّا آخر ضمنيًّا، وكان من المهم أن ينبع هذا الصوت الضمني الإضافي من داخلها هي، السارد الرئيسي، الوحيد، لأن الرواية بها حالة تعتمد تقنيًّا على الإفراد بطريقةٍ ما: شخصية واحدة (الشابة)، ومكان الواحد (البيت الطيني)، ولدينا أيضًا نحن البشر مكان واحد واحد نعيش فيه (كوكب الأرض).
عبر صفحات الرواية.. الألوان تتحرك والرائحة تبتسم، فتبدو الأشياء وكأنها تنبض وتتأثر مثل البشر.. فلماذا اخترت تجسيد الأشياء والألوان والروائح؟
هذا ما أفعله في الكتابة، وأُصدِّقه في الواقعي واليومي، كل شيء له روح وشخصية ولغة وحياة كاملة، أنا أكتب ما أصدقه. في الواقع، أكتب عن الأشياء مثلما أتصوَّر حياتها، كما أنّ هذا، بطبيعة الحال، يمنح النص الأدبي المزيد من الحياة، ورؤيته الخاصة.
تتضمن الرواية وصفًا متعمقًا للتفاصيل، مثل وصف الأفعال اليومية للبطلة، وكذا وصف أدق مقتنيات البيت الطيني في منتصف الرواية تقريبًا، فهل هناك مبرر فني لذلك؟
من البداية، كانت خطتي في الكتابة، ألّا تنتمي البطلة، الشخصية الرئيسية، لثقافة معينة، فلا نعرف المكان الذي جاءت منه، ولا حتى اسمها، في حين أنّ البيت الطيينى به أشياء لها خصوصية ثقافية مثل آلة عصر الزيتون، أو الرحى. وبالتالي لو أنها عرفت هذه الأشياء من النظرة الأولى، سيدلّ هذا على المكان، أو الثقافة التي جاءت منها، هي تصفها لنا كأنها تراها لأول مرة، يُفترَض أنها بالفعل تراها لأول مرة، وفي الوقت نفسه هناك احتمال أنها رأتها من قبل، لكن، الفتاة، بهذه الطريقة، تظلّ غير منتمية لأيّ مكان محدّد أو ثقافة معينة، هي فقط تنتمي إلى كوكب الأرض.
تنتهي الرواية بلا جلاء قطعي وحاسم للغموض الذي عايشناه عبر صفحاتها.. هل كان ذلك مقصودًا لهدف محدد أم لإثارة خيال القارئ ليشارك كلٍ بوعيه في تسطير تفسير ملائم؟
تنتهي الرواية بإشارة إلى أنّ الأرض ستعود، بكل ما فيها، نعرف هذا عندما ترى الفتاة أخاها عَبْر النافذة وهو يمُرّ أمامها، ثم وهي تنظر عبر النافذة ، تقول أرى، وأرى، وأرى، ما تراه هنا هو عودة الأرض.