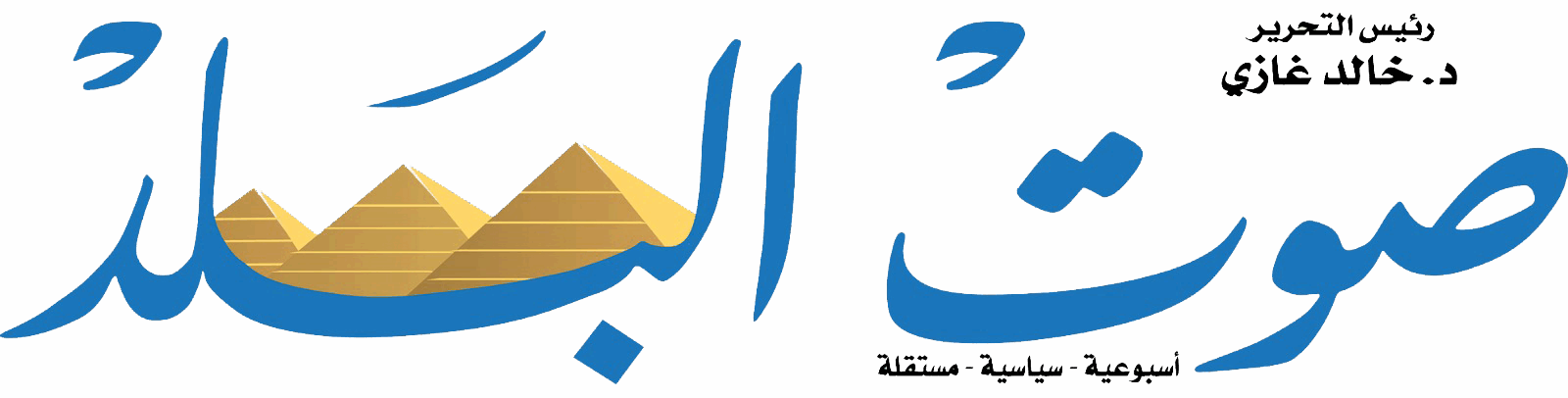عالمنا قرية صغيرة تتلاقى فيها الشعوب بمختلف الثقافات والأفكار والآداب، تتحاور وتتفق وتشتبك، على جسر الترجمة؛ فهو فن يقوم على فهم الآخر ومشاعره وليس مجرد النقل الحرفي لكلماته؛ وكلما كان المترجم مبدعًا ومتمكنا كانت ترجمته قادرة على إحداث ذات الأثر في نفوس المتلقين مع اعتزازه بهويته.
يعد الدكتور خالد توفيق أستاذ دراسات الترجمة وعلم اللغة بجامعتي القاهرة والجامعة الأمريكية، أحد أبرز المبادرين والمجددين في فن الترجمة؛ وهو من الأوفياء لمدرسة أستاذه شيخ المترجمين محمد عناني والذي نقل روائع كلاسيكيات الأدب الإنجليزي بعيون أديب عربي.. وعلى الدرب سار د.خالد توفيق وأثرى المكتبة بإصدارات شتى في حقول الترجمة بكل فروعها، كما تأمل واقع الترجمة وما يدور في كواليس مطبخها العالمي..
في السطور التالية حوار مع “توفيق” حائز درع الشخصية الأكثر تأثيرًا عربيًا في استطلاع مؤسسة “ترجمان العرب” لعام 2024.. ويطوف بنا في أسرار اللغة الإنجليزية العالمية وكيف نتعامل معها بروح عربية .. إلى التفاصيل
كيف تصف رحلتك مع أستاذك محمد عناني، وقد جمعتكما رسالة تطويع ملكات الترجمة لصالح الثقافة العربية؟
تعرفت على د.محمد عناني منذ 1991 وبدأت رحلتي معه التي أصبح فيها بمثابة أبي الروحي لأكثر من ثلاثين عامًا حتى رحيله. لا شك أنه قد أضاء لي خلال تلك الرحلة جوانب عظيمة في معنى الأستاذية وتكريس الحياة للقراءة والعلم، وفي معاني تتخطى حدود البحث الأكاديمي وتنطلق لآفاق إنسانية فكان صديقا مقربا من طلابه ويعرف حياتهم وهمومهم. ومن جهة أخرى تبرز قيمة “عناني” المترجم المبدع الذي قدم للمكتبة العربية روائع الترجمات لمشاهير الأدب العالمي ومنهم شكسبير بلغة إبداعية عربية تبرهن على أن الترجمة هي إبداع موازٍ.
كان عناني مثلا للعطاء بلا حدود ومؤمنا بأن حديقة العلم تزهر بهذا الشكل، وقد أكسبني شخصيا صفات منها الشغف بالعلم والارتحال للجذور الثقافية الكامنة خلف المفردات.
هناك قيمة استثنائية أيضا في مدرسة عناني وهي الاعتزاز المطلق بالهوية واللغة العربية؛ وتوجيه بوصلة الترجمة من الإنجليزية لا بوصفها استبدالا لثقافتنا بأخرى أجنبية، وإنما هي غرس لجذورنا في تربة الحضارة الإنسانية والاكتساب منها والإضافة عليها، وهذا ما سعيت لاقتفائه في حياتي العملية.
في كتابكم الأحدث “أسرار اللغة الإنجليزية” تتحدث عن اللغة ككائن حي؛ يزدهر أو يموت بحسب رعاية قومه .. فكيف يزدهر لسان العرب؟
دائمًا كنت أطالب بتغيير شامل في طرق تدريس اللغة العربية بحيث لا تظل نصوصا جامدة وإنما تتحول لنصوص تفاعلية ومتحركة ومحفزة على تذوق جماليات اللغة التراثية والمعاصرة، مع اهمية تغيير الصورة النمطية لمدرس اللغة العربية في الدراما والتي تثير السخرية لا التبجيل. على الدولة ايضا أن تفعّل الضوابط والتشريعات التي تجرم انتهاك اللغة العربية في حياتنا العامة ومن ذلك أسماء المحال، وكافة دول العالم المتقدم تفعل الشيء نفسه، بل ودولة الاحتلال العبرية تجرّم استخدام يافطات بغير لغتها، إدراكًا لقيمة اللغة في صياغة شخصية أي شعب وواقعه الحضاري.
الكتاب يحمل صورة شكسبير فما وجه فرادة هذا العملاق، وكيف تأثرت بنصوصه؟
بدأت علاقتي بنصوص شكسبير مع الدراسة الجامعية، وتأثرت بالطبع بمسرحياته “هاملت” و”ماكبث” و”عطيل” و”حلم ليلة صيف” ورأيت كيف حوّل الصراعات الداخلية إلى حوارات كونية لا تزال معانيها الإنسانية مستمرة حتى اليوم، كالجملة الشهيرة في هاملت: “أكون أو لا أكون… ذلك هو السؤال” التي تُلخّص أزمة الوجود الإنساني. لكن عظمة شكسبير التي أكسبته مكانته هي التي عبّر عنها الناقد أنتوني بيرجس حين قال بأن شكسبير أحدث منعطفًا في تاريخ اللغة والأدب الإنجليزي بنحته تعبيرات واستعارات وعبارات لم تكن مستخدمة من قبل، من عينة “ليس كل ما يلمع ذهبًا” (من تاجر البندقية)، وبالتالي فشكسبير ليس مجرد كاتب، بل مهندس للغة اخترق حدود الزمن بتعابيره التي تجاوزت 1700 كلمة وتعبيرا صنعوا منها قاموسًا مستقلا.
تؤكد في الكتاب أن الإنجليزية قد استعارت 80% من كلماتها من لغات أخرى، مع ذلك فهي اللغة العالمية المتداولة.. كيف حدث ذلك؟
بالفعل أثبته العلماء أن الإنجليزية قد استعارت 80% من مفرداتها من لغات أخرى (لاتينية/فرنسية/يونانية)، ومع ذلك فهي اللغة الأولى عالميا، وقصة ذلك تعود للتوسع الاستعماري البريطاني؛ فالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس فرضت لغتها كلغة إدارة وتعليم في مستعمراتها مثل الهند وأفريقيا، كما جاءت القيادة الأمريكية في القرن العشرين وتحديدا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا شك أن هذا الصعود قد دعم مركز الإنجليزية عالميا خاصة لو علمنا أن 29% من الأبحاث العالمية تنتج في أمريكا، وأنها تسيطر على 70% من محتوى الإنترنت بالإنجليزية ولغة البرمجة أيضا.
لقد اكتسبت الإنجليزية مكانة كبيرة من ذيوع الأدب الإنجليزي مع قوة نشره وترجمته، فقد مكن التقدم العلمي للغرب من تبوء صدارة النشر والترجمة العالمية، في كل فروع المعرفة، وبالطبع يحدث ذلك باللغة الإنجليزية. وما ذكرناه ليس مستغربًا، فالدولة القوية تفرض لغتها، خاصة لو كانت منتجة للعلم، كما كانت دولة العرب في العصور الذهبية ودولة الأندلس.
تقتحم الروبوتات الذكية كافة المجالات في عالمنا.. فهل ستلغي دور المترجم البشري؟
لا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر أبدا، فالروبوت مثلا لم يلغ دور الجراح داخل غرفة العمليات، وهكذا حال الترجمة؛ فالأصل أن الإنسان لا يمكنه أن يتصدى للتطور التكنولوجي، ودورنا هو تطويعه لخدمة البشرية. ودور المترجم سيصبح أكثر إبداعية وتدخلا فيما تنجزه الآلة من ترجمات، وسيصبح محيط نشاط المترجم البشري فيما وهبه الله إياه من ملكات في العقل لا تدركها الآلة وتتعلق بالحساسية الفريدة تجاه السياقات العاطفية والثقافية المرتبطة باللغة، وهو امر لا يمكن للخوارزميات الإحاطة به منفردة.
محررة صوت البلد والدكتور خالد توفيق
في إحدى محاضراتك تحدثت عن فخ الأيديولوجيا وكيف يتجنب المترجم تعميم الصور المضللة عن قضاياه (فلسطين نموذجًا).. حدثنا عن أمثلة ذلك
كان الباحث بيتر نيومارك يؤكد أن: “الحياد في ترجمة النصوص السياسية خرافة لا وجود لها” فالمترجم ليس آلة وعليه أن يستوعب مرامي الخطاب الذي ينقل منه وبأي لغة يصيغه للجمهور المستهدف.
وفي سياق القضية الفلسطينية نجد مثلا خطورة ترجمة “الاعتداءات الصهيونية”، بوصفها “اشتباكات” وكأن لدينا طرفين متكافئين في الحرب.. أو ترجمة “المستعمرات” بـ”مستوطنات إسرائيلية” وكأنها وطن لهم، بينما هم محتلون. أو تعميم الوصف التوراتي لحائط البراق ووصفه بحائط المبكى، فهذه ألفاظ لها حمولة استعمارية غربية، ودور المترجم هو التخلص من تلك الفخاخ، ولهذا فالمترجم يجب أن يكون مثقفا وواعيا رغم أنفه.
هل ترى أن لدينا مشروعًا قوميا للترجمة كما كان الحلم في التسعينيات؟
المركز القومي للترجمة يقوم بدور طيب في مجالات ترجمة الروائع الأدبية (الروايات، القصائد، المسرحيات) ولكن لازلنا بعيدين عن المقصود بالمشروع القومي للترجمة والذي يفترض به أن يصبح جسرا لأهم ما ينتجه العالم من معارف وآداب، ولهذا ناديت كثيرا بأن تتولى الدولة التعاقد مع كبريات دور النشر العالمية لنقل ثمراتها فوريا للقاريء العربي وهذا سيحدث طفرة حقيقية ويتيح لنا التواصل مع العالم.
ما نصيحتك للمترجمين الشباب؟
دائما أقول بأن القاريء الجيد هو الكاتب الجيد؛ وكلما قرأ المترجم الشاب باللغتين العربية والإنجليزية سيمتلك زمام الترجمة بصورة أكثر احترافية. ولا أنسى يافطة معرض فرانكفورت الدولي الأضخم للكتاب: من يقرأ لا يُهزم!