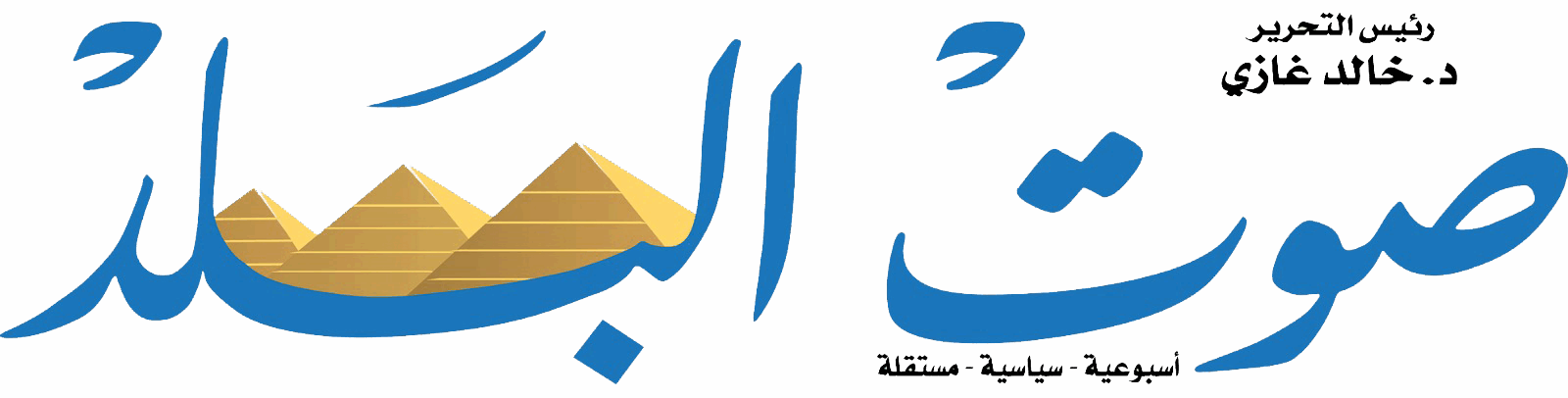يبرزُ المنعطف التاريخي الحاسم الذي نعيشه اليوم كشاهدٍ على صراعٍ وجودي فريد؛ فبينما تتسارع نبضات العصر الرقمي لتبتلع جوهر التجربة الإنسانية في دوامات خوارزمية لا تهدأ، يباغتنا المشهد بلوحة سريالية لافتة، تتجسدُ تناقضاتها في ارتماء جيل 2026 — بكل ما يملكه من ترسانة تقنية فائقة — بين أحضان التسعينيات الدافئة وبساطتها المفقودة؛ حيث إن هذا الارتداد ليس مجرد “نوستالجيا” عابرة أو محاكاة لموضة قديمة، بل هو ظاهرة اجتماعية ضاربة في العمق، وصرخة احتجاج صامتة تبحث عن السكينة وسط ضجيج الحداثة القلق؛ إذ إنها رحلة اغتراب عكسية، يفتش فيها إنسان هذا العصر بين ركام الماضي عن هوية ضاعت في زحام البيانات، سعياً لاستعادة مفهوم “الأصالة” في زمن غدا فيه كل شيء — حتى الشعور — قابلاً للاستنساخ والبرمجة.
إن ما نشهده اليوم ليس نكوصاً إلى الوراء بقدر ما هو بحث عن “زمن البراءة الرقمية”؛ تلك الحقبة التي كانت فيها الحياة أقل تعقيداً، والمشاعر أكثر دفئاً، والأشياء تمتلك وزناً مادياً يمكن لمسه والاحتفاظ به؛ فلقد تحولت “النوستالجيا” إلى آلية دفاع نفسية وفلسفية، سلاحاً أبيض في مواجهة العدمية الرقمية التي تذيب “الأنا” في بحر من “الترندات” العابرة، حيث إن التوق للملموس في عالم افتراضي صقيل وبارد هو فعل “وجودي” بامتياز، ومحاولة لاستعادة السيطرة على “الأنا” التي باتت مرهونة لتوقعات الذكاء الاصطناعي؛ فهذا الهروب الجميل إلى زمنٍ كان فيه الانتظار يمنح الأشياء قيمتها، هو دعوة للتأمل في سرعة الحياة التي تقتل لحظة “الآن” قبل أن تولد، ورغبة في استعادة “الهدوء الزمني” المفقود، فنحن أمام جدلية الحنين ومحاولة لترميم الحاضر بقطع غيار من ماضٍ لا يزال يمتلك بريق الصدق، في محاولة يائسة ولكنها نبيلة للحفاظ على الجوهر الإنساني في عالمٍ يزداد برودة ورقمية.
في اللحظة التي يظن فيها العالم أن قطار التكنولوجيا قد تجاوز المحطات القديمة بلا عودة، يباغتنا جيل “زد” بانعطافة حادة نحو الخلف، فبينما تحلق بنا طموحات الذكاء الاصطناعي في آفاق غير مسبوقة، نجد شبابنا يلوذون بدفء التسعينيات، متمسكين بأزيائها الفضفاضة وألحانها الشجية، وكأنهم يفتشون في ركام الماضي عن “هوية” ضاعت وسط زحام “الخوارزميات”.
ما يتجلى أمامنا اليوم ليس مجرد “موضة” عابرة أو محاكاة شكلية لزمن مضى، بل هو تجلٍّ لظاهرة “الهروب الجميل”؛ فجيل اليوم، الذي وُلد وفي فمه “ملعقة رقمية”، بدأ يشعر بوطأة العيش في عالم افتراضي صقيل وبارد؛ لذا، كان الارتداد إلى التسعينيات هو البحث عن “زمن البراءة الرقمية”؛ ذلك الزمن الذي كانت فيه المشاعر تُكتب بخط اليد، والموسيقى تُقتنى في أشرطة ملموسة تمنح صاحبها شعوراً بالملكية والارتباط، لا مجرد “رابط” عابر في سحابة إلكترونية.
لقد تحولت “النوستالجيا” في عام 2026 إلى آلية دفاع نفسية؛ فالإنسان بطبعه يميل إلى “الأنسنة”، وفي عصرنا هذا، حيث أصبحت الآلة هي المايسترو، باتت تلك السترات الملونة والأغاني التي تعيدنا لزمن “حميد الشاعري” و”عمرو دياب” بمثابة طوق نجاة؛ إنها محاولة لاستعادة “العفوية” التي اغتالها “الفلتر”، وهروب من سطوة “الترند” الذي لا يمنح أحداً فرصة ليتنفس أو يتأمل.
إن عودة هذا الجيل إلى “كلاسيكيات التسعينيات” هي صرخة احتجاج صامتة ضد “التعليب الثقافي”، وإعلان بأن الروح البشرية تظل دائماً منحازة لما هو حقيقي وملموس، بعيداً عن بريق الشاشات الزائف؛ حيث إن النوستالجيا ليست ارتداداً عن الحداثة، بل هي محاولة لتطعيم المستقبل بمسحة من الإنسانية؛ فمهما بلغت سرعة انطلاقنا نحو الغد، سنظل دائماً بحاجة إلى تلك النافذة التي تطل على “زمن الطيبين”، لنستمد منها الدفء الذي يقينا صقيع العالم الرقمي.
عالمٍ “سائل”
إن عودة جيل 2026 إلى أنماط التسعينيات تعكس أزمة “انتماء” حادة في مجتمع وصفه علماء الاجتماع بـ”المجتمع السائل”؛ ففي عالم اليوم، حيث كل شيء مؤقت وقابل للاستبدال بضغطة زر، يبحث الإنسان عن “ثوابت” بصرية وسمعية يرتكز عليها؛ فالتسعينيات، بصفتها آخر الحقب “المتصلة” جسدياً قبل طغيان الانفصال الرقمي، تمنح هؤلاء الشباب شعوراً واهماً ولكنه مريح بأنهم ينتمون لزمنٍ كان يمتلك ملامح واضحة لا تتغير كل ست ساعات.
مواجهة “الافتراضي”
ثمة توق فلسفي جارف للمادة في مواجهة العدمية الرقمية؛ فارتداء قميص كلاسيكي أو اقتناء أسطوانة قديمة هو فعل “وجودي” بامتياز؛ إنه محاولة لاستعادة الحواس الخمس في التعامل مع الأشياء؛ ففي عام 2026، حيث أصبحت ممتلكاتنا مجرد “شيفرات” في السحابة، تصبح النوستالجيا ثورة للملموس على الافتراضي، وإعادة اعتبار للمادة التي يمكننا لمسها، وشم رائحتها، والاحتفاظ بها كجزء من كياننا المادي.
صراع “الأنا” مع الخوارزمية
من الناحية الفلسفية، يعاني إنسان 2026 من “تآكل الفردانية”، حيث إن الخوارزميات تقترح علينا ما نأكل، وما نسمع، ومن نصادق. هنا تبرز أزياء التسعينيات وموسيقاها كأدوات “تمرد سيادي”؛ فاللجوء إلى ذوق قديم هو محاولة لكسر قيد “التوقعات الآلية”، إذ إن الشاب الذي يختار أغنية من عام 1995، إنما يمارس في الحقيقة فعلاً من أفعال الإرادة الحرة، معلناً خروجه المؤقت عن سلطة “الذكاء الاصطناعي” التي تحاول قولبته في نمط استهلاكي محدد.
محاكاة “الأصالة”
في ظل انتشار “التزييف العميق” (Deepfake) الذي بلغ ذروته في 2026، أصبح “الصدق” عملة نادرة؛ ففلسفياً، تمثل التسعينيات في الوعي الجمعي “عصر الحقيقة الأخيرة”، فكانت الصور لا تُعدل، والأصوات لا تُصحح آلياً، إذ إن الهروب إلى ذلك العصر هو بحث عن “الأصالة” (Authenticity) المفقودة؛ وهو محاولة للتصالح مع العيوب البشرية الجميلة التي محاها الذكاء الاصطناعي في سعيه نحو كمالٍ تقنيٍّ بارد ومنفر، حيث يمكن اعتبار هذه الظاهرة تجسيداً لمقولة “نهاية التاريخ” بشكل ثقافي، فعندما يعجز الحاضر عن توليد جماليات جديدة تتجاوز الصدمات التقنية، يرتد الإنسان إلى “الاجترار الثقافي”، إذ إنها جدلية فلسفية مؤلمة؛ فجيل 2026 يحاول ترميم حاضره بقطع غيار من ماضي غيره، مما يشير إلى فجوة روحية عميقة في الحضارة المعاصرة، تجعل من “القديم” هو “المستقبل” الوحيد الذي يبدو آمناً وقابلاً للعيش.