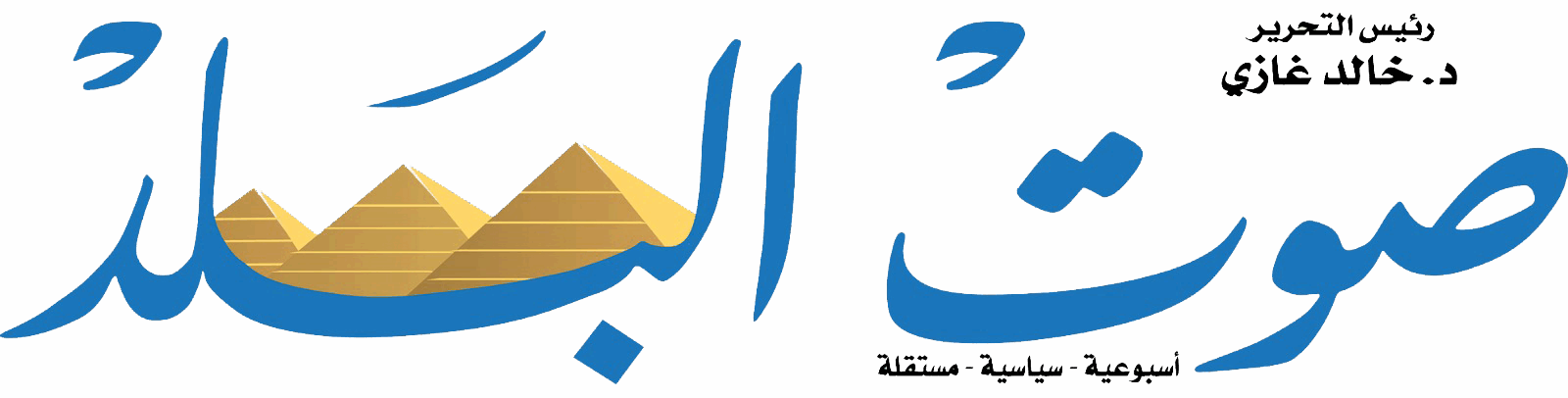قالت الدكتورة صفاء عبد الرحيم برعي، مدير مركز تحقيق التراث بكلية الآداب بجامعة سوهاج، إن عملية تحقيق التراث الفكري هي جسر يربط بين الماضي والحاضر، تتم من خلال الالتزام بالأصالة لحفظ هوية النص، بينما تُقدم بأسلوب معاصر يُسهِّل على الأجيال الحديثة فهمه والاستفادة منه، مؤكدةً على ضرورة الربط بين التراث والواقع بعميق الوعي بالهدف من التحقيق، والتأكيد على أهمية توظيف التراث لخدمة قضايا العصر.
وكشفت في حوارها لـ “صوت البلد” أن نشر المخطوطات في مختلف مجالات الفكر الإنساني يشهد اهتمامًا متزايدًا في العقود الأخيرة، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة تؤثر على جودته وانتشاره بشكل عادل، حيث لا يتم تحقيق ونشر المخطوطات بشكل متوازن في جميع مجالات الفكر الإنساني، وأن هناك حاجة إلى جهود أكبر لتحفيز العمل في المجالات الأقل عناية مثل العلوم التطبيقية، والطب، والفنون، مشيرةً إلى أهمية التوجه نحو دعم أكثر تنوعًا وشمولية يُسهم في حفظ الإرث الإنساني بمختلف أبعاده.
وبينت أن التراث الإسلامي واللغوي يتم تحقيقهما بشكل جيد، لافتةً إلى أن الحفاظ عليهما يساهم في تعزيز الهوية الثقافية للأجيال القادمة، لافتةً إلى أهمية إعداد جيل من المحققين الذين يحملون الأدوات العلمية والأخلاقية لخدمة التراث وإحيائه بما يلائم احتياجات العصر الحديث.
وأوضحت أن المواطن العادي يستفيد من التراث في بناء هويته، وتحسين معرفته، وتعزيز أخلاقه، وكذلك الاستفادة من الحكمة والتجارب التاريخية في حياته اليومية. وأضافت أن نشر التراث بشكل جذاب وميسر يضمن أن يكون هذا الكنز الفكري والثقافي متاحًا للجميع، مشددةً على أهمية إتاحة التراث الفكري الذي يُمثل الهوية الثقافية والحضارية للأمم، ويُسهم في بناء حاضرها ومستقبلها.. وإلى نص الحوار..
هل أي كتب قديمة تسمى تراث، وهل هناك محددات محددة يتم على أساسها هذا التصنيف؟
الكتب القديمة لا تُسمّى كلها “تراث” بشكل عام، بل يُطلق هذا المصطلح على نوعية معينة من الكتب التي تحمل قيمة فكرية، أو علمية، أو ثقافية من نتاج الحضارات السابقة. ولكي يُعتبر الكتاب جزءًا من التراث، هناك محددات يجب توافرها، منها: قيمته، وزمن كتابته، والتأصيل الحضاري، والأصالة، والاستمرارية.
ما هو التراث الإسلامي واللغوي؟
يشير التراث الإسلامي إلى الموروث الحضاري والثقافي للأمة الإسلامية، ويشمل: النصوص الدينية، مثل القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكتب التفسير، والفقه، والعقيدة. وكذلك الإنتاج الفكري في مجالات مثل الفلسفة، التاريخ، الأدب، الطب، الفلك، والرياضيات. وأيضًا الفنون الإسلامية، مثل العمارة، الخط العربي، والزخارف. بالإضافة إلى الموروث الاجتماعي كالأعراف والعادات التي تأثرت بالإسلام. فيما يشمل التراث اللغوي كل ما يتصل باللغة العربية من إنتاج فكري وأدبي، مثل: المعاجم كـ”لسان العرب”، و”القاموس المحيط”. وأيضًا النحو والصرف: مثل كتب سيبويه وابن جني. وكذلك الأدب والشعر: كأشعار العصر الجاهلي والإسلامي. فضلًا عن المخطوطات اللغوية التي تعالج قضايا البلاغة والأسلوبية.
وما أهم وسائل تحقيقهما؟
يتم تحقيق التراث الإسلامي عن طريق جمع النسخ المخطوطة، ومقارنة النسخ لتحديد الأصح والأكمل، والتوثيق والتحقيق، وإعداد الحواشي والشروح بتوضيح المفاهيم والمصطلحات الدينية أو الفقهية التي قد تكون غامضة للقارئ الحديث. وكذا استخدام التكنولوجيا الحديثة والنشر الورقي أو الإلكتروني لضمان وصول النصوص المحققة إلى جمهور واسع. أما تحقيق التراث اللغوي فيتم عن طريق جمع النصوص اللغوية بالبحث عن المخطوطات النحوية، المعاجم، والكتب الأدبية القديمة. وكذا الدراسة المقارنة عن طريق مقارنة النصوص القديمة بمراجع معاصرة لفهم تطور اللغة والمصطلحات. ولابد أن نشير إلى أهمية التحليل اللغوي بتفسير الألفاظ الغريبة والمعاني القديمة، والشرح والتبسيط بإعداد شروح مبسطة للنصوص اللغوية لتناسب القارئ الحديث.
هل يتم العمل على نشر المخطوطات بشكل جيد في جميع مجالات الفكر الإنساني؟
هناك مجالات تلقى اهتمامًا أكثر من غيرها، مثل: الدراسات الدينية والفقهية التي تلقى دعمًا واسعًا من المؤسسات الأكاديمية والدينية. وكذلك الأدب والشعر، فهناك جهود كبيرة في تحقيق دواوين الشعراء ونصوص الأدب الكلاسيكي. وأيضًا العلوم التاريخية والجغرافية، مثل كتب الطبري وابن كثير، و”معجم البلدان” لياقوت الحموي. أما المجالات التي تحظى بعناية أقل، فهي العلوم التطبيقية مثل: الطب، الفلك، الكيمياء، والرياضيات التراثية. ويعود ذلك إلى ضعف الاهتمام بإسهامات الحضارة الإسلامية في هذه المجالات أو نقص المختصين. وكذلك هناك ضعف في نشر الفلسفة والفكر النقدي، ربما بسبب تعقيد النصوص أو حساسية بعض موضوعاتها. وأيضًا الفنون والموسيقى لم تحقق وتنشر بشكل جيد.
وما الأسباب العامة التي تحد من النشر المتوازن؟
قلة المختصين في بعض المجالات، مثل: العلوم الطبيعية أو الفنون من أهم أسباب قلة النشر.، وأيضًا ضعف التمويل المادي، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المخطوطات النادرة أو الموزعة بين مكتبات خاصة أو بلدان بعيدة.
إذن.. كيف يمكن تحسين النشر في جميع المجالات؟
التوازن في التمويل والدعم في المجالات المهمّشة كالعلوم التطبيقية والفنون أمر مطلوب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المكتبات ودور النشر في العالم لتوفير المخطوطات وتحقيقها، وإعداد كوادر متخصصة في تحقيق المخطوطات بمختلف المجالات الفكرية، وتوفير النصوص المحققة إلكترونيًا.
ما أبرز المشكلات التي تواجه محققي التراث خلال عملهم؟
يواجه محققي التراث العديد من المشكلات أثناء عملهم، أبرزها: صعوبة قراءة المخطوطات القديمة بسبب الخطوط غير الواضحة، أو استخدام رموز غامضة، أو تأثر المخطوط بالعوامل الزمنية كالرطوبة والتلف. وكذلك اختلاف النسخ وتعدد الروايات، وفقدان بعض الأجزاء، وغياب الهوامش والشروح، بالإضافة إلى قلة الموارد المادية والدعم. هذا فضلًا عن صعوبة الوصول إلى المخطوطات بسبب وجودها في مكتبات خاصة أو بلدان أخرى. وأيضًا التحديات اللغوية والمصطلحية بسبب استخدام مصطلحات أو لغة قديمة يصعب فهمها في العصر الحالي.
كيف نتغلب على هذه المشكلات؟
يمكن التغلب على هذه المشكلات بتبني تقنيات “الرقمنة” والحفظ الإلكتروني، وتدريب جيل جديد من الباحثين على مهارات التحقيق، ودعم مشروعات التعاون الدولي في حفظ المخطوطات وتحقيقها. بالإضافة إلى نشر المخطوطات المحققة بطرق تيسر الوصول إليها إلكترونيًا، وإنشاء مجامع لغوية تهتم بدراسة المصطلحات التراثية وتفسيرها.
كيف يتم إعداد جيل من المحققين لخدمة التراث ؟
إعداد جيل من المحققين لخدمة التراث يتطلب خطة شاملة تشمل التعليم، والتدريب، والتوجيه لضمان إتقان المهارات اللازمة لفهم وتحقيق النصوص التراثية، وإعادة إحيائها بطريقة علمية تخدم العصر الحديث. وأرى أن التأهيل العلمي والتربوي هو الأساس، فلا بد من تعليم العلوم الأساسية، وهي علوم اللغة العربية، والعلوم الشرعية، وأيضًا العلوم التاريخية والاجتماعية لفهم سياق النصوص. وكذا لابد من تطوير التفكير النقدي بتدريب المحققين على التفكير التحليلي والنقدي لتمييز الصحيح من الضعيف في النصوص. وأرى أن إتقان منهجيات التحقيق من الأمور الهامة، عن طريق دراسة مناهج التحقيق للتعرف على أسس تحقيق النصوص، مثل جمع النسخ الخطية ومقارنة الاختلافات بينها. ولا نغفل في ذلك أهمية التدريب العملي، وتوظيف التكنولوجيا لإنشاء مكتبات رقمية، وتدريب المحققين على استخدام قواعد البيانات الرقمية للمخطوطات. هذا فضلًا عن ضرورة إقامة مراكز متخصصة، وتنظيم دورات تدريبية يقدمها متخصصون في مجالات التحقيق، وتشجيع البحث العلمي وتكليف الطلاب بتحقيق مخطوطات معينة كجزء من دراساتهم. وأيضًا تحفيز الإبداع بالتشجيع الكتابة عن قضايا التراث وأهميته في الكتب والمقالات. وأشير هنا إلى أهمية دعم أخلاقيات التحقيق عن طريق تعليم النزاهة العلمية بغرس قيم الأمانة والدقة في التعامل مع النصوص، ورفض التلاعب أو حذف أجزاء من النصوص لأهداف شخصية.
ما سُبُل الموازنة بين الأصالة والمعاصرة في تحقيق التراث؟
هذه عملية دقيقة تتطلب الجمع بين الالتزام بالدقة في الحفاظ على النصوص التراثية، وتقديمها بشكل مفهوم ومناسب للقارئ المعاصر. يمكن تحقيق ذلك عن طريق الحفاظ على أصالة النص من خلال الإشارة إلى الفروق بين النسخ، وتجنب إسقاط معايير أو تفسيرات معاصرة على النص الأصلي. وأيضًا لابد من مراعاة متطلبات القارئ المعاصر عن طريق تقديم شروح للمصطلحات الغريبة أو الغامضة، وتحسين التنسيق والإخراج ليتناسب مع المعايير الحديثة، مع الحفاظ على روح النص القديم. ومن الضروري أيضًا إضافة مقدمات تحليلية لشرح أهمية النص وسياقه التاريخي وأهداف التحقيق. هذا فضلًا عن أهمية توظيف التكنولوجيا في التحقيق ونشر النصوص إلكترونيًا لزيادة الوصول إليها، والاستفادة من المناهج الحديثة بتطبيق مناهج نقد النصوص لتحديد الأجزاء الأصيلة وإبرازها. ولا نغفل تعزيز الحوار بين الماضي والحاضر لإبراز القيمة المعاصرة للنصوص التراثية من خلال توضيح كيفية استفادة المجتمع الحالي من النصوص القديمة، سواء في العلوم، أو الفقه، أو الأدب. ووضع رؤية تأصيلية لمشكلات العصر أي استخدام النصوص التراثية كنقطة انطلاق لفهم قضايا معاصرة مع المحافظة على سياق النصوص الأصلي.
وكيف يمكن أن يخدم التراث واقعنا المعاصر؟
خدمة التراث لواقعنا المعاصر تعتمد على استثمار محتواه وإعادة توظيفه بطريقة تحقق الفائدة للمجتمع الحديث. وذلك بجعله حيًا ومتفاعلًا مع الحاضر، بحيث يظل أداة للتقدم وليس مجرد ذكرى من الماضي. يمكن أن يتم ذلك عبر عدة طرق، منها: تحليل التراث وفهمه وتوضيح أبعاد الفكر التراثي الأصيلة التي تخدم قضايا الهوية والانتماء. هذا فضلًا عن أهمية إحياء العلوم والمعارف بإعادة نشر كتب التراث بطريقة مبسطة أو منقحة لتصبح متاحة للجميع. ويمكننا أيضًا الاستفادة من التجارب السابقة واستخدام التراث العلمي والتقني كمرجع لبناء معارف جديدة، مثل اختراعات المسلمين في الطب والفلك. كذلك يمكن توظيف التراث في التطوير والإبداع بتحويل الأفكار التراثية إلى منتجات أو مشروعات إبداعية، مثل استلهام التصاميم أو القصص التراثية في الأدب والفنون. ويمكن استخدام التكنولوجيا لخدمة التراث عن طريق إنشاء تطبيقات ومنصات إلكترونية تقدم التراث بطريقة تفاعلية. هذا بالإضافة إلى إمكانية تعزيز القيم الإنسانية التي حملها التراث، مثل العدل، التسامح، والتعاون، وتطبيقها في بناء مجتمع أفضل. واقترح أن يتم إدراج محتوى من التراث العربي والإسلامي في المناهج الدراسية لتقوية ارتباط الطلاب بجذورهم. فضلًا عن إمكانية تطوير السياحة الثقافية والتراثية لجذب الزوار واستثمار المواقع التراثية.
إذن.. هل المجتمع في حاجة إلى نشر وعي أكبر بأهمية التراث الفكري، أم هو أمر خاص بالصفوة والمثقفين؟
المجتمع ككل في حاجة ملحّة إلى نشر وعي أكبر بأهمية التراث الفكري والإسلامي، وليس أمرًا مقتصرًا على الصفوة والمثقفين فقطـ، بل هو مسئولية مجتمعية لمواجهة التغريب والاندثار، والحماية من فقدان الهوية بسبب العولمة أو الاستلاب الثقافي. وكذلك يمكننا الاستفادة من الحكمة المتراكمة وتنمية الفهم المشترك، لبناء جسور التواصل بين الأجيال المختلفة، وبين الشعوب ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة.
ما أهم أشكال استفادة المواطن العادي من نشر التراث؟
نشر التراث الفكري يُسهم في تحسين الحياة على المستويين الفردي والمجتمعي. فالتراث يحتوي على معارف وتجارب إنسانية في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، الصحية، وغيرها التي يمكن أن تساعد في حل مشكلات الحياة اليومية، مثل: التعاليم الأخلاقية والدينية، والنصائح الطبية والتراثية في مجالات العلاج الطبيعي. والمواطن العادي يمكنه تحسين فهمه للعالم من خلال التعرف على التراث الثقافي والفكري، من خلال فهم تطور المجتمعات وأسباب نجاحها أو أزماتها، مما يُمكن المواطن من المساهمة في تحسين واقعه. كما أن التراث يمكن أن يكون مصدر إلهام للأعمال الإبداعية، بالإضافة إلى تعزيز الفخر الحضاري لمواجهة العالم بروح إيجابية.
كيف يمكن تيسير إتاحة التراث الفكري للمواطنين ونشر الوعي به؟
دمج التراث في التعليم من أهم طرق تيسير إتاحة التراث للمواطن، وذلك بإدخال قصص وأمثلة من التراث في المناهج المدرسية والجامعية بشكل مبسط ومناسب لمراحل التعليم المختلفة، وتنظيم فعاليات ثقافية مثل: المعارض، والندوات، والأيام الثقافية والمهرجانات لإبراز أهمية التراث بطريقة مشوقة، والتعريف بالتراث الفكري وأهميته، وتقديمه بأسلوب يناسب القارئ العادي. وأيضًا استخدام وسائل الإعلام لنشر برامج ثقافية تُبرز أهمية التراث الفكري من خلال محتوى ممتعًا ومفيدًا. ويمكن رقمنة المخطوطات والموروثات الفكرية بلغة بسيطة لتسهيل الوصول إليها من خلال الإنترنت.