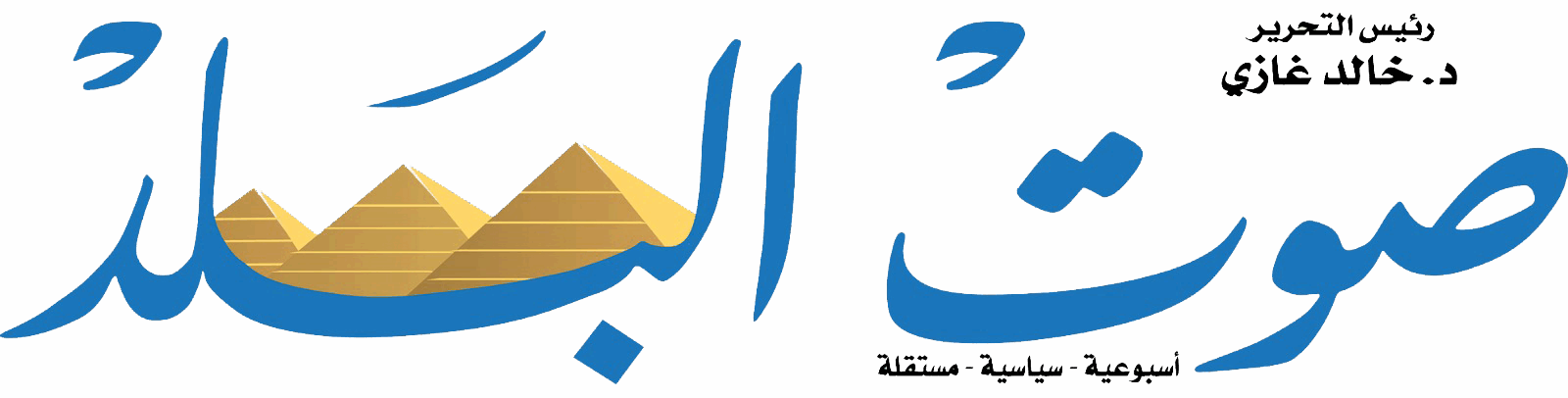السعادة لا تحتاج تعريفات كبيرة، ولا وعود براقة، ولا خطط معقدة. هي في الأساس نتيجة طبيعية لفهم أعمق للنفس، ولطريقة تعاملنا مع ما نراه، وما نسمعه، وما نسمح له أن يؤثر علينا.
بهذه الرؤية تدعونا نجلاء حمدي، أخصائي التربية والصحة النفسية، لاستهلال العام الجديد بفهم أعمق للسعادة والنجاح والحياة المفعمة بالرضا والبصيرة والاتزان، برغم وتيرة حياتنا الضاغطة والمؤلمة، وهو أيضا موضوع رسالتها للماجستير حول “القلق الرقمي” .
وسألناها: كيف نفهم السعادة ونستدعيها لحياتنا؟
السعادة هي حالة اتزان داخلي، تسمح لنا بأن نمر بالتقلبات دون أن نفقد أنفسنا، أو نعيش في صراع دائم مع الواقع. وهي محصلة ثلاثة علاقات محورية؛ تبدأ من صلتك بالله، ويقينك بأن أقدارك تكمن خلفها حكمة إلهية، وهذا الشعور بحد ذاته يمنحك قوة ذاتية وسواءً نفسيا، ثم نصل لمحطة العلاقة الإيجابية بالآخرين من حولك.
والتخطيط للسعادة لا يعني الهروب من الألم، بل يعني تقليل الاستنزاف، وزيادة المساحة الداخلية للهدوء. ودعونا نتفق أن السعادة ليست حالة دائمة لكن بإمكاننا دعوتها دائما لحياتنا فقط حين نعرف نقطة البداية.وعملية استدعاء السعادة تحتاج خطوات بسيطة، لكنها حقيقية؛ فالسعادة لا تُبنى بقفزات كبيرة، بل بتغييرات صغيرة متكررة.
علينا أن نفهم أن السعادة لا تحتاج أن نصبح أشخاصًا آخرين، ولا أن نعيش حياة مثالية، بل أن نكون أكثر صدقًا مع أنفسنا، وأكثر رحمة بما نشعر به. لذا فإننا في عام جديد لا نحتاج بداية صاخبة، بل بداية واعية… هادئة… تشبهنا.
كيف تلعب وسائل التواصل دورًا في إشاعة القلق والإحباط؟
بالتأكيد، حين تصبح المقارنة أسلوب حياة؛ فجزء كبير من شعورنا بعدم الرضا اليوم لا يأتي من حياتنا نفسها، بل مما نراه عن حياة الآخرين. ووسائل التواصل الاجتماعي خلقت مساحة مفتوحة للمقارنة المستمرة، دون أن نشعر؛ نقارن يومنا العادي بلقطات مختارة من حياة غيرنا، ونقارن تعبنا الحقيقي بنجاحات مُعلنة، ونقارن رحلتنا الكاملة بلحظة واحدة من حياة شخص آخر.
هذه المقارنات لا تكون عادلة، ولا واقعية، لكنها متكررة بما يكفي لتزرع شعورًا خفيًا بالنقص، حتى عند أشخاص يملكون أسبابًا حقيقية للرضا. ومع الوقت، يتحول التصفح من وسيلة تواصل إلى مصدر ضغط ذهني دائم.
ماذا يحدث داخل أجسامنا حين نقلق؟
القلق ليس فكرة فقط، بل حالة جسدية كاملة. مع التوتر المستمر، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، التي تُبقي الإنسان في حالة استعداد دائم، وكأن الخطر قريب. هذه الحالة، إذا طالت، تؤثر على إفراز هرمون السيروتونين، المسؤول عن الشعور بالرضا والهدوء. وحين يقل هذا الهرمون، يصبح من الصعب الاستمتاع حتى بالأشياء الجيدة الموجودة فعلًا في حياتنا. هنا لا تكون المشكلة في قلة النِعَم، بل في إرهاق الجهاز العصبي.
ما السبيل لاستعادة توازننا النفسي في العصر الرقمي؟
أن نختار ما نتابعه، وأن نسمح لأنفسنا بمساحات صمت بعيدًا عن المقارنة المستمرة. أن نعتني بالجسد كجزء من العناية بالنفس من خلال الحركة اليومية، النوم الجيد، والتعرض للشمس فهي ليست تفاصيل ثانوية، بل أساس للتوازن النفسي. وننصح دائما بالتعامل الواعي مع وسائل التواصل الاجتماعي، كيفًا وكمًا، وليس الانسحاب او العزلة؛ إنما فهم طبيعة تلك البلورة التي نرى منها حياة الآخرين وكثيرا ما ننخدع فيها، وننسى في ظل انشغالنا بالآخر الافتراضي، أن نحيا حياة حقيقية!.
لقد أثبت العالم كارل روجرز أن الإنسان له ذوات متعددة؛ ذات يرى نفسه بها وأخرى يرغب في أن يراه الناس بها، ولهذا تسبب المقارنات الاجتماعية أي شعور بالسعادة مهما وصل الإنسان لإنجازات لأنه يرى بمرآة ما يريده المجتمع وليس ما تريده ذاته، فأنى له أن يصل للسعادة، في مجتمع يفرض عليه حياة لا تشبهه. وكلما ابتعدت عن ذاتك فلن تشعر يوما بالسعادة وستصبح ضحية لدوامات القلق تلتهمك بلا هوادة.
حين نفشل.. هل علينا وضع خارطة أخرى للنجاح؟
أحيانا نحتاج لضبط بوصلتنا لنفهم أصلا ما هو النجاح؛ فالنجاح ليس نسخة واحدة تناسب الجميع. والنجاح هو أن يعيش الإنسان حياة تشبهه، لا حياة تُرضي التوقعات فقط.
والأهداف الحقيقية هي التي تخدم الإنسان لا تستنزفه. لذا فقبل أي هدف جديد، من المهم أن نسأل: هل هذا الهدف يضيف لحياتي، أم يزيد الضغط دون معنى؟
وإذا كنت واثقا من هدفك وملاءمته لحياتك وخبراتك أيضا، فعليك أن تسعى له بلا كلل، وأن تتذكر أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن تنشط في إحاطة نفسك ببيئة داعمة تدعمك بروح إيجابية لمواصلة الطريق.
كيف ندعم الامتنان بنفوسنا ونهرب من ذكريات الألم؟
أحيانًا نجد أنفسنا غير قادرين على تذكّر اللحظات الجميلة، بينما تتكدّس في الذاكرة المواقف المؤلمة.
نتساءل: لماذا تتشبث عقولنا بالألم وتترك النِّعَم خلفها؟ والحقيقة أن الذاكرة البشرية ليست جهازًا محايدًا يسجل كل ما يمرّ به الإنسان، بل هي آلية بقاء، صُممت لتُبقي ما يحمي الإنسان من الخطر في الواجهة.
والألم بالنسبة للعقل إشارة خطر، لذلك يحتفظ به جيدًا كي لا يتكرر، بينما يرى اللحظات الجميلة كأمان مؤقت لا يحتاج إلى تخزين طويل. ويلعب العقل العاطفي أيضًا دورًا مهمًا؛ فالمشاعر السلبية تثير الجهاز العصبي بقوة، وتفرز هرمونات مثل الكورتيزول، فتُرسّخ الذكريات المؤلمة أكثر من الإيجابية.
أما اللحظات السعيدة، فتأتي بهدوء، وتغادر بذات الهدوء. لكن الجميل أن هذا ليس قدرًا محتومًا. يمكن تدريب العقل على تذكّر النِّعَم واللحظات الدافئة. الكتابة اليومية للأشياء الجميلة،
والتأمل في النعم الصغيرة، والاحتفاظ بصور أو كلمات تعبّر عن المواقف الطيبة — كلها أدوات تُعيد بناء الذاكرة على أساس الامتنان. وعندما نبدأ في تذكّر الخير، يحدث شيء عميق في الداخل: تتوازن الصورة، ونكتشف أننا لم نكن نعيش وسط الألم فقط، بل كان هناك جمال كثير مرّ دون أن ننتبه له.
فالذاكرة ليست مجرد سجلّ، بل مرآة لما نختار أن نُبقيه حيًا فينا.
اقرأ أيضا: “جسر القناديل” .. من قال أن النسخة الثانية ستصبح أسعد