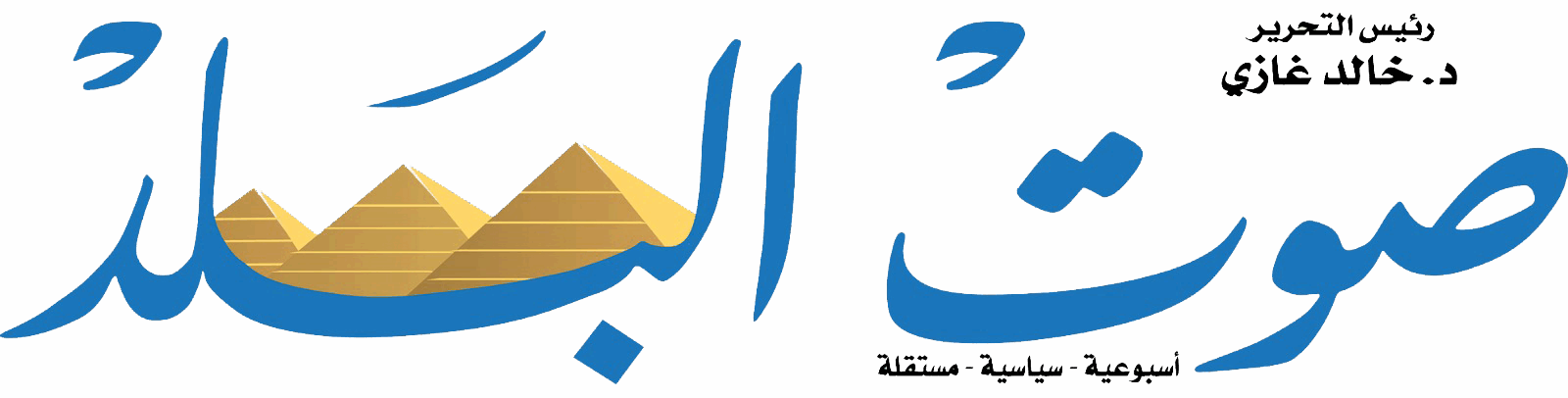الدكتور كمال جاد الله أستاذ مساعد الأدب المقارن بقسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوزارة الأوقاف. حصل على دكتوراه الأدب العام والمقارن من جامعة باريس 3 “السوربون الجديدة”. له العديد من الأعمال والكتب المترجمة والمنشورة عن الإسلام، بالإضافة إلى مقالات في الدين والحياة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وكُتب مثل: “التيسير في أعمال الحج”، و”نظرية الحرب في الإسلام للإمام الدكتور محمد أبو زهرة، و”الله ليس كذلك” للكاتبة الألمانية زنجرد هونكة، فضلًا عن المشاركة في ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية، والذي لا زال تحت الطبع.
وعن الأدب المقارن، أجرت معه “صوت البلد” حوارًا، حيث قال إنه يُعد بوابة العبور من الأدب الوطني إلى الأدب العالمي، كما أنه يُعد أيضا بابًا يتم من خلاله التلاقح الثقافي وتشارك الهموم الثقافية، مضيفًا أن هذا الحقل المعرفي قد تطور في فرنسا منذ عشرينيات القرن الماضي وبالتحديد منذ 1924، ثم في الولايات المتحدة منذ الخمسينيات.
وأضاف أن مجال دراسة هذا الحقل العالمي هو الأدب الذى أُنتج أولا في أوروبا ثم في بقية العالم، مؤكدًا أن هناك آداب ذات تأثير عالمي وعلى رأسها الأدب الفرنسي الذى وجد أصداءًا كبيرة في عالمنا العربي، كما لفت إلى أنه تم تخصيص جزء كبير من الإنتاج “الإستشراقي” لربط الإرهاب بالإسلام بشكل تعسفي، وذلك بتأثير اللوبى الصيهوني في الفضاء الفكري والعلمي والثقافي والإعلامي في الغرب.. وإلى نص الحوار..
هل كان للأدب الفرنسي دور في تشكيل الثقافة المصرية والوعي المجتمعي في أمور ما؟
بدايةً لابد من الإشارة إلى خصوصية الحالة الثقافية المصرية وعلاقتها بفرنسا. فمع أن مصر كانت محتلة من قبل بريطانيا إلا أن التأثير الثقافي السائد بها كان فرنسيًا عكس ما حدث ببقية المستعمرات الفرنسية. لذلك تشكلت النخبة المصرية من الدارسين المصريين في فرنسا فى عهد محمد علي باشا والى مصر المحب لفرنسا. وقيل في سيرته أن من ضمن من تعهدوا طفولته وتربيته كان رجلًا فرنسيًا. وهذا يفسر فيما بعد علاقته الخاصة بفرنسا من خلال البعثات العلمية التي كان أغلب طلابها من أبناء الأزهر إلى جانب أبناء الأسر التركية. كما تجلت هذه العلاقة في بناء الجيش المصري الحديث على يد ضباط نابليون الذين تم تسريحهم عقب الحروب النابليونية التي انتهت في 1814، وعلى رأسهم الكولونيل سيف الذى أسلم وتسمى سليمان باشا الفرنساوى، وكذلك في الطب والجغرافيا والصيدلة والزراعة والبيطرة وغيرها بحيث أصبحت النخبة المصرية تلاميذ العلم والفكر الفرنسي. وكان من ثمار الفكر الفرنسى في الثقافة العربية بشكل عام كتاب رفاعة الطهطاوى بك ثم باشا “تخليص الإبريز في تلخيص باريز” وبقية مؤلفاته التي تتسم بالليبرالية الفكرية والانفتاح على تعليم البنات وإدخال العلوم الحديثة في التدريس إلى جانب العلوم الدينية. وفى مجال الأدب ترجم “تليماك” للكاتب مونتانى. وفى نفس الحقبة كان بشير الشهابي في لبنان يقود حركة تنوير فرنسية، وكان خير الدين التونسي من رواد هذا الاتجاه في تونس. ولأن الخديوي اسماعيل كان قد تعلم في فرنسا ضمن بعثة الأنجال رفقة علي مبارك فقد أدخل الأوبرا والمسارح ونمط الحياة الفرنسية في القصور، وتسللت تلك العادات إلى بيوت الأعيان. وكان من ثمار هذا التلاقح الفكري ظهور مفكرين كبار صنعوا النهضة الفكرية مثل قاسم بك أمين، وسعد باشا زغلول، والإمام محمد عبده الذي تعلم الفرنسية كبيرًا، وتلميذة أحمد لطفي السيد باشا، مدير الجامعة المصرية آنذاك. كما انتشرت المدارس الفرنسية حتى أن النخبة المصرية كانت تتحدث فيما بينها بالفرنسية.
كيف ظهر ذلك على الأسلوب السردي وعناصر الرواية أو الثيمات الأدبية ذاتها؟
يمكن أن نرى ذلك في المسرح الشعرى عند أحمد بك شوقي، وبشكل خاص في الفن الروائي، حيث تعد رواية “زينب” لمحمد حسين هيكل باشا وزير المعارف من بواكير هذا الفن. ولقد درس هيكل الحقوق في فرنسا وحصل منها على الدكتوراه وتأثر بالأدب الفرنسي إلى حدِ كبير، وظهر هذا التأثر في أعماله. فقصة الحب في تلك الرواية تشبه قصص الحب شبه المستحيل في روايات ستانال وفلوبير، والوصف الريفي يحاكي الوصف عند بلزاك وزولا. واستمر تأثر الرواية العربية بالرواية الفرنسية عند طه حسين، ومحمد عبد الحليم عبد الله، ونجيب محفوظ تأثر ببلزاك، لاسيما في الوصف الذي ينتقل بسلاسة من العام إلى الخاص من مدينة القاهرة إلى حي الحسين أو العباسية، ثم إلى الحارة، ثم البيت، ثم داخل البيت.
ما هي أكثر الدول العربية التي تأثرت بالأدب الفرنسي؟ وبأي الكتاب الفرنسيين تأثرنا بشكل أكبر؟
تعد مصر وبلاد الشام (سوريا الكبرى) من أول الأقطار العربية التي تأثرت بالأدب الفرنسي، وذلك بسبب التقارب بين هذه الدول وفرنسا منذ بدايات القرن التاسع عشر، ثم تلتها بلاد المغرب العربي، حيث ظهرت الرواية العربية المتأثرة بالفرنسية والرواية الفرانكوفونية أو ما يعرف بالأدب المغاربى الناطق بالفرنسية. ويعد بلزاك من أكثر الأدباء تأثيرًا على الأدب العربي يليه زولا وفلوبير، وذلك في إطار المدرسة الواقعية. أما في تيار الرومانسية فقد تأثر الأدباء العرب بكلِ من لامارتين وشاتوبريان وستاندال وألفريد دو موسيه. وقد تأثر هيكل، ويوسف السباعي، ومحمد عبد الحليم عبدالله بالأدباء الفرنسيين. فيما يظهر تأثر نجيب محفوظ ببلزاك في جميع رواياته تقريبًا من خلال الوصف الدقيق التصويري وكأن القارئ يرى المكان بعينه
هل أثرت الحركة النسوية في فرنسا بعد صدور كتاب “الجنس الثاني” لسيمون دو بوفوار على الحركة النسوية في مصر؟
الحركة النسوية في مصر تأثرت بنظيرتها الفرنسية منذ بواكيرها ، وذلك من خلال الصالونات مثل صالون الأميرة نازلي، ثم صالون مي زيادة، ثم خروج النساء في ثورة 1919 بقيادة هدى شعراوي التي اتخذت اسم زوجها علي شعراوي باشا على عادة الفرنسيين. وقد عرفت الحركة النسوية المصرية سيمون دو بفوار منذ الستينيات لاسيما بعد حضورها إلى مصر بصحبة جان بول سارتروقد، حيث أصدرت كتابها “الجنس الثاني” أو “الجنس الآخر” وهي في عامها الثامن والثلاثين وذلك عام 1949 ولاقى هجومًا من جانب الفاتيكان. وتقول دو بفوار في مقدمته “إن الإنسانية في عرف الرجل شيء مذكر فهو يعتبر نفسه يمثل الجنس الإنساني الحقيقي أما المرأة فهي في عرفه تمثل الجنس الآخر”. ومن بين من تأثرن بسيمون دوبوفوار من التسويات المصريات نجد نوال السعداوي خاصةً في كتابها “الأنثى هي الأصل”.
هل تعتبر رواية “السنوات” لآني إرنو، ورواية “سفاح القربى” لكريستين أنجو بداية ظهور الرواية الذاتية كنوع أدبي؟
ظهرت الرواية الذاتية كنوع أدبى في العالم العربي قبل أرنو بزمن طويل متأثرةً بكتاب “الاعترافات” لجان جاك روسو، وهو سيرة ذاتية وافية تتسم بالصدق حتى في أدق التفاصيل المخجلة. على عكس روايات السير الذاتية مثل “الأيام” لطه حسين، مع تصويرها الدقيق لواقع الريف المصري بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فلم تكن من الصدق بما كانت عليه اعترافات روسو. وقد أثرت آني أرنو بكتاباتها المكشوفة على الرواية الذاتية في العالم العربي وعلى رأسها “السنوات”، وكذلك “زنا المحارم” أو “سفاح القربى” لكريستين أنجو أثرت أيضًا على تطور الرواية الذاتية نحو مزيد من الصدق حتى في سرد التفاصيل المشينة، حيث يتجلى ذلك في “الخبز الحافي” لمحمد شكري، و”حملة تفتيش أوراق شخصية” للطيفة الزيات، و”رحلة جبلية” لفدوى طوقان وغيرها.
أي حقبة زمنية تأثر خلالها الأدب العربي بالأدب الفرنسي؟
بدايةً من الثلث الأول للقرن العشرين ومع ظهور مدرسة التجديد ظهر تأثر الأدب العربي في فن الرواية بالأدب الفرنسي، وإن ظهر قبل ذلك بعقدين تقريبًا فص الشعر، لاسيما في المسرح الشعري عند شوقي، حيث استلهام التاريخ على غرار كورني، وجوديل، ومارمونتل، وراسين، وذلك في “مصرع كليوباترا”، و”قمبيز”، وغيرها. وانتقل التأثير إلى الرواية التي انتقلت من كونها فنًا ثانويًا إلى تصدر الأجناس الأدبية إلى حد أن سماها الدكتور جابر عصفور “ديوان العرب” بدلًا من الشعر.
في فرنسا الحديثة حاليًا.. هل ما زال الأدب الفرنسي الذي ينتقد المجتمع الحديث مثل رواية “الاستسلام” لميشيل أوليمبك مؤثرًا على المجتمع المصري أو المحافل الأدبية؟
يتسم الفكر الفرنسي دائمًا بالمراجعة ونقد الذات، وهو ما يجعل المجتمع حيًا ومتيقظًا لعيوبه التي يحاول علاجها باستمرار. في الأدب المقارن هناك أوجه للتأثر، ومنها الترجمة، ولا أدل على تأثر الفضاء الثقافي العربي بتلك الأعمال من الإسراع إلى ترجمتها إلى العربية. وقد صدرت ترجمة رواية “استسلام” إلى العربية عام 2015 للمترجم والناقد شكير نصير الدين ضمن منشورات الجمل، مما يدل على أصدائها في الفضاء الأدبي العربي.
بعيدًا عن الكلاسيكيات.. هل ما زالت الأعمال الأدبية الفرنسية تُترجم حاليًا؟
الترجمة حركة مستمرة لكن الوضع الراهن للترجمة محبط، خاصةً فيما يتعلق بالأعمال الأدبية، حتى أن سلسلة فكرية عظمية مثل “عالم المعرفة” تعلن دائمًا عدم إدراج الأعمال الإبداعية على قوائمها. لكن “المركز القومي للترجمة” يبذل مجهودًا عظيمًا في هذا المجال. يُضاف إلى ذلك الأعمال الأدبية المترجمة لأغراض أكاديمية، وتغلب عليها الروايات الجديدة الصادرة في القرن الحادي والعشرين، لكن الترجمة الأدبية تحتاج عملًا مؤسسيًا بميزانية مناسبة. نجد أن دولة أوربية مثل إسبانيا تترجم أكثر مما يترجم العرب جميعًا، وهو وضع مؤسف للغاية، خاصةً وقد كان “بيت الحكمة” في بغداد أول وأكبر مؤسسة ترجمة في العالم منذ أكثر من 1200 عامًا.
ما تقييمكم للأدب العربي حاليًا؟
يشهد الأدب العربي حاليًا العديد من التحديات، وعلى رأسها الميديا الجديدة، والتي يمكن أن تتحول إلى ميزة حال التوسع في النشر الإلكتروني. وهناك أيضًا تحدي غياب القارئ الحصيف أو الناقد، أضف إلى ذلك الضعف الحالي في اللغة العربية، وتقديم موضوعات لا تشتبك غالبًا مع الواقع الأدبي المتأزم. ومع ذلك لا يعدم الأدب العربي كتابًا مجيدين مثل مكاوي سعيد، وعلاء الأسواني وغيرهم.
ما هي أسباب ضعف الحركة الإستشراقية حاليًا بشكل عام؟
منذ أواخر القرن العشرين لم تعد حركة الإستشراق كسابق عهدها فقد تم تفكيكها لسببين: أولًا أن كلمة الإستشراق أصبحت سيئة السمعة، لاسيما بعد أن تم ربطها بالإمبيريالية من قبل إدوارد سعيد، وثانيًا من أجل مزيد من التخصص، فتفكك الإستشراق إلى مستعربين، وأثريين، وعلماء إسلاميات، ومتخصصين في النقوش والعملات، ومؤرخون. تم تخصيص جزء كبير من الإنتاج “الإستشراقي” لربط الإرهاب بالإسلام بشكل تعسفي، وذلك بتأثير اللوبي الصيهوني في الفضاء الفكري والعلمي والثقافي والإعلامي في الغرب. وأرى أنه لابد من حوار نزيه بين الشرق والغرب يتضمن التساوي في المراكز، والقفز فوق العقد التاريخية، والنزاهة في الأحكام، والإيمان بأن قضايا التحرر والتنمية والحريات من حق جميع الشعوب وليس الغرب وحده.