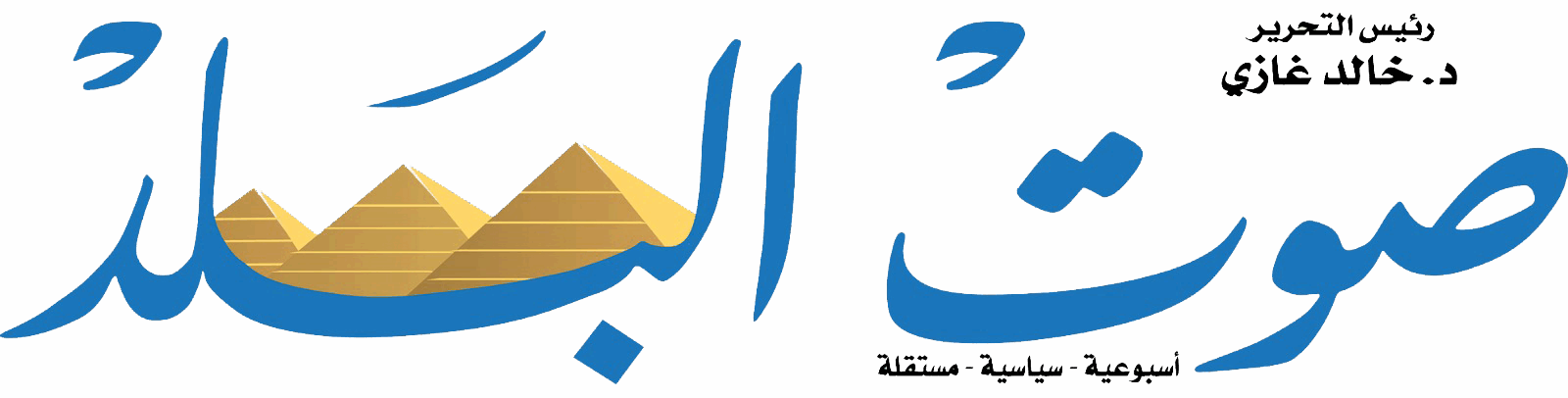في عالم تسيطر عليه ثقافة “الاستعراض الرقمي” والمقارنات اللحظية، لم يعد الحقد مجرد شعور إنساني عابر، بل تحول إلى ظاهرة هيكلية تضرب استقرار المجتمعات وبيئات العمل، إذ يشخص خبراء علم النفس والاجتماع الحقد اليوم بوصفه “انفعالاً مركباً” يمزج بين العجز، الغضب، والرغبة في الهدم.
سجن “المقارنة الظالمة”
يرى المحللون أن انفجار منصات التواصل الاجتماعي عزز من “متلازمة المقارنة”؛ فعندما يرى الفرد نجاح الآخرين خلف الشاشات دون إدراك لجهدهم الخفي، يتولد لديه شعور بالظلم الشخصي. هذا الشعور لا يدفعه لتطوير نفسه، بل يوجه طاقته نحو تمني زوال النعمة عن الآخر، وهو ما يفسر تصاعد ظاهرة “التنمر المنظم” والحملات التشويهية الرقمية.
الحقد المهني
في أروقة المؤسسات، باتت “الأحقاد الوظيفية” عائقاً رئيسياً أمام الابتكار، إذ تُشير التقارير الإدارية إلى أن الموظف الحاقد يستهلك جزءاً كبيراً من طاقته الذهنية في مراقبة زملائه وتدبير المكائد بدلاً من التركيز على الإنجاز، حيث إن هذا المناخ السام يؤدي إلى هجرة الكفاءات، مما يكبد المؤسسات خسائر فادحة ناتجة عن تراجع الروح الجماعية.
حين يقتل الحقد صاحبه
من الناحية الفسيولوجية، أثبتت الدراسات الطبية أن الحاقد هو الضحية الأولى لمشاعره؛ فالحالة المستمرة من التربص والانفعال المكتوم تؤدي إلى إفراز مزمن لهرمونات التوتر مثل “الكورتيزول”، مما يرفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، فالحقد حرفياً هو سم يتناوله الإنسان ويظن أن الآخر هو من سيموت.
استحقاق وهمي
تبرز في المجتمعات الحديثة ظاهرة يطلق عليها علماء الاجتماع “حقد الاستحقاق”، وهي ناتجة عن تربية تعزز لدى البعض وهم أنهم يستحقون كل شيء دون جهد يذكر. وحين يصطدم هؤلاء بواقع يتطلب الكفاح، يوجهون سهام حقدهم نحو الناجحين معتبرين تميزهم مجرد “ضربة حظ”، مما يخلق فجوة مشحونة بالكراهية.
على مستوى أوسع، يتجاوز الحقد الأفراد ليصل إلى الجماعات، حيث تشهد النزاعات المختلفة استثماراً في “الأحقاد التاريخية” والطبقية، إذ يتم شحن الجماهير لتغذية كراهية “الآخر” المختلف؛ وهذا النوع من الحقد الجماعي يُستخدم كأداة فعالة لتفتيت المجتمعات من الداخل وإشعال فتيل النزاعات العرقية والأيديولوجية.
لذة مسمومة
تعتبر “الشماتة” هي الابنة الشرعية للحقد، حيث يجد الحاقد لذة غريبة في تعثر الخصوم أو وقوعهم في الأزمات. هذه اللذة العابرة تعوضه مؤقتاً عن شعوره بالنقص، لكنها تعمق هوة القطيعة الاجتماعية، إذ إن تحول “سقوط الآخر” إلى مصدر للاحتفال هو مؤشر خطير على انهيار القيم الإنسانية المشتركة وتحول المجتمع إلى غابة من التشفي.
حقد “المرآة”
ظاهرة نفسية غريبة تفسر لماذا يتركز الحقد غالباً بين الأقران (زملاء المهنة الواحدة، الأقارب، الجيران)؛ فالشخص لا يحقد على ملك أو ملياردير بعيد عنه، بل يحقد على من يشبهه في البداية ثم تجاوزه. هنا يعمل الآخر كمرآة تذكر الحاقد بفشله أو تقاعسه، فيحاول كسر تلك المرآة (أي تشويه الشخص الناجح) ليرتاح من رؤية قصوره الشخصي.
يلعب البيت دوراً محورياً في صناعة الحاقدين؛ فالآباء الذين يمارسون الغيبة والنميمة ويقارنون أبناءهم بالآخرين بشكل سلبي، يزرعون بذور الحقد في نفوس الصغار، حيث ينشأ الطفل وهو يرى في نجاح ابن عمه أو جاره تهديداً لمكانته، فيكبر بقلب “محمل بالأثقال” لم يخترها بنفسه، بل ورثها كجزء من الهوية العائلية المشوهة.
يتخفى الحقد أحياناً وراء أقنعة براقة، مثل “النصيحة القاسية” أو “النقد الموضوعي”، حيث يسعى الحاقد هنا إلى تحطيم معنويات الطرف الآخر تحت مسمى الصراحة أو الحرص، وهي ممارسة تسمى “العدوان السلبي”. هذا الالتفاف السلوكي يجعل مواجهة الحاقد صعبة، لأنه يتلاعب بالحقائق ليوهم الضحية بأن الخلل فيها وليس في قلبه المشتعل كراهية.
الدرع النفسي
في مواجهة هجمة الأحقاد، يبرز مفهوم “الصلابة الذهنية”، إذ إن التعامل مع الحاقد يتطلب تجاهلاً ذكياً وليس مواجهة صدامية تستهلك الطاقة، حيث إن أفضل رد على الحاقد هو “الاستمرار في النجاح” وبناء جدران عازلة تحمي الخصوصية؛ فعندما يدرك الحاقد أن سهامه لا تصل، وأن نيران غيظه لا تحرق إلا صدره، يضطر للتراجع أو البحث عن ضحية أخرى أقل حصانة.
لا يمكن مواجهة الحقد بالقمع، بل بنشر ثقافة “الاستغناء والامتنان”، حيث تتوجه المبادرات التربوية الحديثة نحو تعزيز “الذكاء العاطفي”، وتدريب الأفراد على تقبل الاختلاف، إذ إن الحل يبدأ من التصالح مع الذات؛ فكلما زاد رضا الإنسان عن إنجازه الشخصي، تضاءلت حاجته لمراقبة نعم الآخرين بعين حاقدة.
إن الحقد ليس قدراً محتوماً، بل هو خيار نفسي وتراجع أخلاقي؛ لتظل “سلامة الصدر” هي الحصن الأخير الذي يحمي الإنسان من التحول إلى مجرد صدى لكراهية الآخرين، وهي الضمانة الوحيدة لمجتمع سويّ قادر على العطاء والبناء.