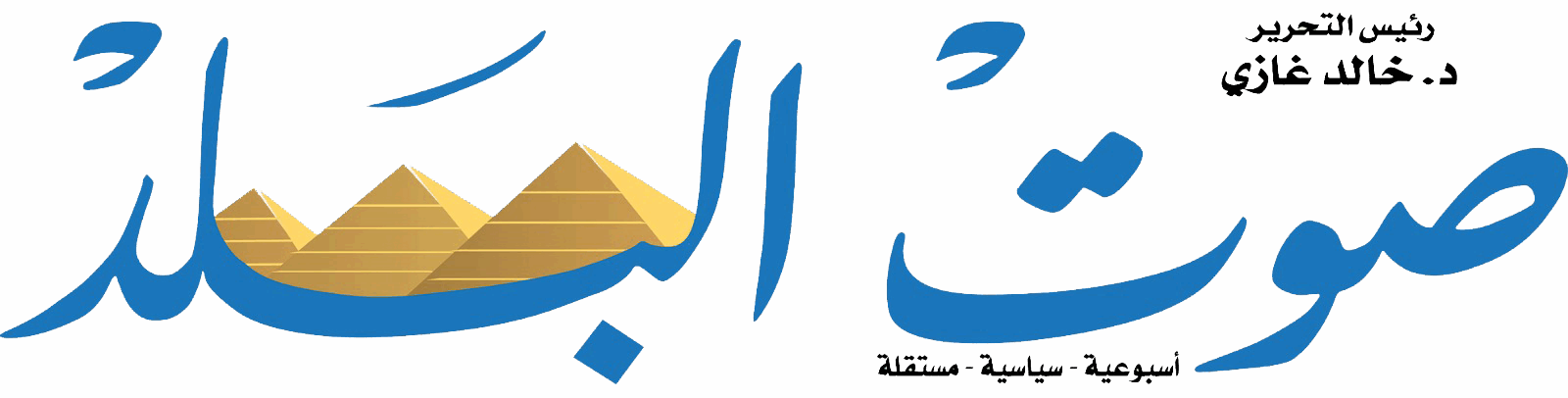يمثل الكاتب سمير الفيل صوتاً متفرداً وشاملاً؛ بدأ شاعراً ثم غاص بقوة في عالم القصة القصيرة، ليحفر اسمه بأحرف من نور في سجل الإبداع. مسيرته الأدبية توجت بالعديد من الجوائز المرموقة، بدءاً من جائزة أبها الثقافية عام 1992، مروراً بـجائزة الدولة التشجيعية (2016)، وجائزة يوسف أبورية (2017)، وجائزة ساويرس (2020)، وصولاً إلى جائزة “الملتقى” الكويتية للقصة القصيرة العربية عام 2024.
إلى جانب إبداعه الروائي والقصصي، الذي تميز بالاقتراب من نبض الشارع وهموم البسطاء ورصد تحولات المجتمع المصري، كان “الفيل” صحفياً بجريدة “اليوم” السعودية، وأقام ورشاً إبداعية لسنوات طويلة. كما لعب دوراً محورياً في حفظ التراث الثقافي، حيث شارك في جمع التراث اللامادي لصالح اليونسكو، موثقاً حكايات الجدات وألعاب الأطفال. ولم يغفل أدب الطفل أو أدب الحرب، فقدم مساهمات بارزة في المسرح ومجموعات قصصية هامة مثل “خوذة ونورس وحيد”. وحتى اليوم، يواصل الكاتب السبعيني عطاءه الغزير، متخذاً من المقاهي منصة لحلقات إبداعية شعبية، ومنجزاً أربع مجموعات قصصية في العام الماضي وحده.
لدى هذا الكاتب المخضرم كثير من الأسرار الإبداعية وتجارب الحياة الثرية التي تستحق أن تروى، ولذلك كان لـ”صوت البلد” هذا اللقاء الشامل معه، لنغوص في عوالمه ونفتح صفحات جديدة من الحوار الصريح والشفاف…
كيف أثرت الجوائز في مسيرتكم الأدبية؟
أكتبُ، بوجهٍ عام، حين تراودني فكرة أو يلحُّ عليّ سؤال. أنطلقُ بوعيٍ وفهمٍ للبحث عن الجذور الكامنة تحت السطح، وأسعى لتعميق معرفتي بالآخر وبالذات في آنٍ واحد. فأغلب مجموعاتي القصصية انطلقت من إحساسٍ جارفٍ بالحزن أو البهجة، أو كمحاولةٍ لفهم هذا العالم المتشابك الذي أعيشه، فكل نصٍ أدبيٍ هو حالةٌ خاصةٌ من التأمل ورغبةٌ في كشف المستتر والمخبوء، لذلك تجدني دائمًا في حالة ترقبٍ وشغفٍ لفك شفرة العالم، وربما العوالم التي تحيط بي. أنا لا أكتبُ من أجل الجوائز، بل أجدني في سباقٍ دائمٍ مع الزمن كي أصنع معزوفتي الخاصة ضمن لحنٍ لا نهائي يعزفه الساردون. ربما لهذا السبب، جاء فوزي بعدة جوائز.

يرتكز مشروعكم السردي بشكل كبير على “الحارة المصرية” والشخصية الأصيلة. لماذا هذا الانحياز الدائم للبسطاء والمهمشين في أعمالكم؟
أنا ابن مدينةٍ حرفيةٍ، خرجتُ إلى العمل في سن الخامسة. هذا الأمر لم يسبب لي ضيقاً أو نفوراً من الحياة؛ فقد كنت أعمل وألعب في آنٍ واحد. كانت طفولةً خشنةً لكنها سعيدة. كانت ورش العمل قادرةً على الاستفادة من “الصبية” في إنجاز مهام بسيطة لكنها ضرورية، مثل حمل قطع الأثاث من مكان إلى آخر، والعودة بقطع الخشب من ماكينة الشق في أغلب الحارات والأزقة، ناهيك عن “أحبال الكرينة” ووضعها في الشمس لتتحمص قبل حشو المقاعد بها (قبل استخدام خامة الإسفنج الصناعي).
تعلمتُ من الحارة الشعبية التي عشت في كنفها أهمية الدقة وسرعة الإنجاز؛ لأن مشروع “الورشة” يُقيَّم بـ”الطلبية”. وفي الوقت ذاته، كنا نلعب ونختلس الوقت لنفرح بألعاب الطفولة، ومنها “الطقة بعجة” و”الكرة الشراب” و”السبع طوبات” و”ركبت خيولها”. أفادني ذلك في دمج الخبرة المبكرة بالحياة مع العمل في نطاق الزقاق.
ولتعلم أنني رأيت رفعت الفناجيلي يلعب الكرة في حارة “النفيس”، وشاهدت “السنجق” البورسعيدي يلعب في شارع متفرع من “باب الحرس”. وهكذا ألممتُ بمفردات الحارة في صباي المبكر، وهو ما يتجلى في ثلاث مجموعات قصصية هي: “صندل أحمر”، و”مكابدات الطفولة والصبا”، و”هوا بحري”. هذه النصوص التحم فيها الذاتي بالموضوعي إلى حد كبير.
يمكنني القول إنني كتبتُ عما أعرف: ما رأيته، أو سمعته، أو وجدتُ نفسي في بنيته الصلبة. وهذا منحني طاقةً شعوريةً غمرتني بالحنين والأشواق وشطرٍ من المعرفة. وهي معرفةٌ ممارسةٌ لا قراءة كتبٍ فقط.
خضت تجارب أدبية متنوعة ما بين القصة والرواية والمسرح. أي من هذه الأجناس أقرب إلى قلب سمير الفيل؟
بدأت حكايتي مع الشعر بعد عام واحد من هزيمة يونيو 1967، ثم بدأت كتابتي الجادة في عام 1969، وحزت جائزة في المؤتمر الأول للأدباء الشبان بالزقازيق، ديسمبر 1969. شاركت في ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب والتقيت صلاح جاهين وعبدالرحمن الأبنودي وسيد حجاب.
في عام 1974، أقيمت أول مسابقة لأدب الحرب، وفازت قصتي “في البدء كانت طيبة” بالجائزة الأولى، ونُشرت القصة في مجلة “صباح الخير”. وفي السنوات التالية، شاركت بقصص في مسابقات نظمتها الشؤون المعنوية بالجيش المصري.
بحكم اشتغالي بالتدريس، كتبت مسرحيات للأطفال، وكان أغلبها استعراضات؛ لأنني استفدت من خبرتي الشعرية في كتابة أغاني لتكون العروض مبهجة.. في ذات الأجواء، التقيت بمحارب من الأنساق الأولى للقتال هو الشاعر مصطفى العايدي الذي حكى لي ظروف العمليات العسكرية، كما انخرطت في كتائب قتالية بعد عام من الحرب في مناطق فايد وسرابيوم والدفرسوار، وكتبت رواية “رجال وشظايا” وهي من الروايات التي تحمس لها جمال الغيطاني، ونُشرت في سلسلة “أدب أكتوبر” التي كان يتولى رئاسة تحريرها بمساعدة خيري عبد الجواد.
منذ عام 2000، تعرفت على شبكة الإنترنت، ونشرت في موقع “القصة العربية” 150 عملاً في وجود القاص جبير المليحان، ثم استقر جهدي الرئيسي في مجال القصة القصيرة، فأنجزت ثلاثين مجموعة قصصية في الفترة من عام 2001 وحتى عام 2025، وتوجد حالياً ثلاث مجموعات قصصية تحت النشر.
أعتقد أنني وصلت أخيراً لقناعة تشير إلى أن عطائي الأوفر في القصة وليس في غيرها من الدوائر الإبداعية الأخرى. وهنا أشير إلى تبني الدكتور عبد القادر القط لموهبتي ونشر أعمالي في مجلة “إبداع”.
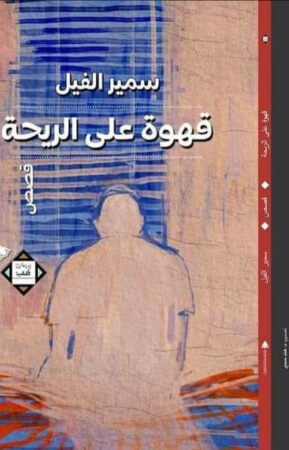
بدأت مسيرتك كشاعر قبل أن تتجه للسرد وتصبح “شاعر القصة” كما يلقبك البعض. هل لا يزال الشعر يداعب مخيلتك؟ وكيف أثر في لغتك السردية؟
أكتبُ القصة القصيرة باستمرار، وفي أحيانٍ قليلةٍ جداً، أذهب إلى الشعر مثلما فعلت في برنامج “العودة إلى الجذور” مع تكريم القاص محسن يونس، وهو ما فعلته أيضاً في قصيدةٍ أهديتها لصديقي مسعود شومان. لكنني سرعان ما أعود إلى القصة ففيها أتنفس بشكلٍ طيّع.
لاحظ أنني أنجزت خمسة دواوين قبل اتجاهي للقصة القصيرة، وهذا معناه أنني تخلّيت عن الشعر لأسبابٍ قهريةٍ ليس هذا مجال البحث فيها. بل إن الديوان الأول “الخيول” تحول إلى عرضٍ مسرحيٍ بعنوان “غنوة للكاكي” في المهرجان الأول لنوادي المسرح 1990 من إخراج شوقي بكر، وألحان توفيق فودة.
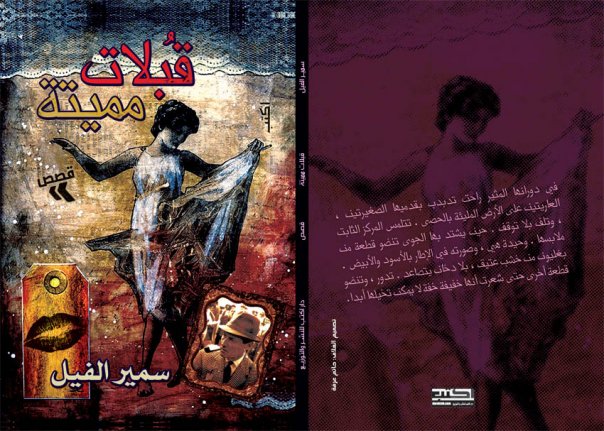
“دمياط” حاضرة بقوة في كل أعمالك تقريباً، بأجوائها الخاصة وورشها ومقاهيها. هل تعتبر نفسك “مؤرخاً” للحياة اليومية في دمياط بقدر ما أنت أديب؟
يعتبرني البعض مؤرخاً للحياة اليومية في مدينتي دمياط، وأعتبر الأمر أبعد من ذلك، فشخصياتي لها جذورها في عمق التربة المصرية، ولا يمكنني انتزاع تلك الشخصيات من واقعها انتزاعاً فهي تعيش واقعها، وتخضع للضغوط التي تعرضها للفشل والتمزق أحياناً، كما أن نفس هذه الشخصيات لها أحلامها ومباهجها. ربما تمثل دوائر الإحباط أشكالاً ترميزية لمجمل الحياة في بر مصر. لا يمكنني التخلي عن خبرتي الشخصية لرصد العلاقات وتثبيتها في مجال القص، لا أكرر الواقع بل أحرره من النمطية.
في بعض أعمالك مثل “عقد من الماس المغشوش”، نلاحظ ميلاً نحو الفانتازيا والرمزية، بخلاف الأسلوب الواقعي المعتاد. ما سر هذا التحول؟
نعم، أعتقد أنني تمكنت من الانفلات من قبضة الواقع المهيمن إلى فضاءات من التخييل والفانتازيا والسحر المرتبط بمرور شخصياتي في دوائر الهم، والالتزام بأعراف الجماعة. ذلك هو مأزقهم الذي يحيط بهم في عنف وقسوة، فتكون الرمزية والفنتازيا تحايلاً على قتامة الواقع.

عُرف عنك رفضك الانتقال للعيش في القاهرة، وفضّلت البقاء في دمياط. هل كان هذا القرار متعمداً للحفاظ على “نقاء” تجربتك الأدبية بعيداً عن صخب العاصمة؟
لم يكن قراراً مقصوداً أو متعمداً، لكنني وجدت أن حالة الهدوء والبعد عن الصخب أليق ما تكون بتجربتي الأدبية، وحافظت على حالةٍ من البعد عن الإعلام لتخمل أعمالي سمة النقاء والعفوية والبساطة التي تميز كل قصصي التي كُتب عنها رسالة دكتوراة مع الدكتور عبد المنعم أبو زيد، ورسالتا ماجستير مع الباحثة هبة زغلول، والباحثة حنان سمير الأشقر.
كيف تقيّم المشهد الأدبي المصري والعربي حالياً؟ وما رأيك في الجيل الجديد من الكتاب؟
لست مخولاً بالحديث عن عموم الحالة الأدبية في مصر أو العالم العربي، ما أقدمه هنا هو اجتهاد. لكن ظرفاً استثنائياً جعلني أقترب من الصورة، وخاصة بعد زيارة ثلاث بلدان في عام 2024، وهي الكويت وقطر والأردن، حيث اقتربت من مجال القصة القصيرة بشكل أكثر من ذي قبل.
في مصر، هناك أصوات مُعلَّمة لها عندي تقدير كبير: عبد الحكيم قاسم، بهاء طاهر، محمد خليل قاسم، إبراهيم عبد المجيد، سلوى بكر، محمود عوض عبدالعال، هالة البدري، جار النبي الحلو، محمد المخزنجي، محمد المنسي قنديل، محسن يونس.
وفي الحلقة الوسطى، وجدت عطاءً عظيماً لكل من: عزت القمحاوي، محمود الورداني، وحيد الطويلة، عادل عصمت، منتصر القفاش، سيد الوكيل، محمد الراوي، حجاج أدول، نجوى شعبان، محمد إبراهيم طه، عفاف السيد، عبد المنعم الباز، سمير الأمير، مصطفى نصر، أحمد صبري أبو الفتوح، أحمد فضل شبلول.
ومن الأجيال الجديدة، وجدت أصواتاً مدهشة: طارق إمام، محمد عبد النبي، منير عتيبة، حسن عبد الموجود، فكري داود، نورا ناجي، ضحى عاصي، هبة الله أحمد، حسام المقدم، دعاء البادي، حسين منصور، خبيب صيام، وعابد المصري، دعاء البطراوي، هبة السويسي.
وفي رحلاتي الأخيرة، تعرفت على الكاتب المغربي أنيس الرافعي، وهو قاص يكتب بطريقة مختلفة، شيقة وفريدة. قبله، قرأت لأحمد المديني “احتمالات البلد الأزرق”، ومن الجزائر قرأت أعمال الرائد محمد ديب، وقرأت واسيني الأعرج، كما شاركت إسماعيل برير في مائدة نقاشية بالقاهرة، مارس 2025، وهو قاص مجيد، سبق أن حصل على جائزة الطيب صالح.
بالطبع، توقفت أمام أعمال سميحة خريس وجلال برجس في الأردن. كما تعرفت على أعمال الدكتورة هدى النعيمي والدكتور أحمد عبد الملك من قطر. من كتاب الكويت: ليلى العثمان، ثريا البقصمي، طالب الرفاعي، سعود السنعوسي، أفراح الهندال، أستبرق أحمد، والمهندس حميدي حمود المطيري (وقد زارني في دمياط)، وغيرهم.
ولقد قضيت في السعودية أربع سنوات مشتغلاً بالتحرير الصحفي، وأعرف من كتاب القصة المجيدين: عبد العزيز مشري (وحررت عنه كتاباً في سلسلة “آفاق عربية” 2003)، وعبده خال، وأميمة الخميس، وفالح الصغير، ورجاء عالم، ويوسف المحميد، وعبد العزيز الصقعبي، حسين علي حسين (وقد زارني في دمياط). وهناك كتاب شباب رافقتهم في البدايات، منهم: عبد الله التعزي، وعبد الله الوصالي، وفهد المصبح، حيث كنا نقيم (أنا وأحمد سماحة) ورشة متنقلة للسرد في الدمام والإحساء والقطيف والجبيل. كما كنت أحرر باباً أسبوعياً بجريدة “اليوم”، باسم “كتابات” بالاشتراك مع الشاعر حسن السبع، وهناك التقيت بالأخوين: علي الدميني ومحمد الدميني، ولهما كتابات سامقة. شاركت وقتذاك في تقديم مقالات عن الفن التشكيلي في مجلة “النص الجديد”.
القصة السورية مدهشة: قرأت لنبيل سليمان وخليل النعيمي وشهلا العجيلي، وكتبت عن خليل الرز، وماجد رشيد العويد. تجولت في شوارع الرقة عامي 2007 و2008 مع الدكتور سيد البحراوي ويوسف أبو رية.
كذلك أنا مفتون بروايات اللبنانية هدى بركات، خاصة “حجر الضحك” و”أهل الهوى”.
في فلسطين المحتلة، قرأت لأميل حبيبي، وغسان كنفاني، ليانة بدر وحسن حميد، محمود الريماوي، يحيى يخلف، وكنت على صلة قوية بالدكتور زكي العيلة من سكان غزة.
من السودان، تعرفت على كتاب منهم هشام آدم، وزارني بدمياط. ومن كتاب تونس، قرأت للدكتور أصيل الشابي وكتبت عنه.
الحقيقة أن شجرة القصة العربية يانعة ومثمرة، ولها أفرع مثقلة بالثمار.
في ظل الثورة التكنولوجية، هل لا يزال للكتاب الورقي مكانته في قلوب القراء؟
تصوري الخاص، ربما ، لأنني من الجيل القديم، هو أن الكتاب الورقي ضروري في الأبحاث العلمية والمراجعات النقدية. أما الكتاب الإلكتروني فهو يسد نقصاً ويتخطى الحدود وستتضاعف أهميته في السنوات المقبلة. أؤمن بالتعايش بين جميع الوسائط بما فيها الكتاب الإلكتروني أو الكتاب السمعي، وما يستجد من تقنيات.
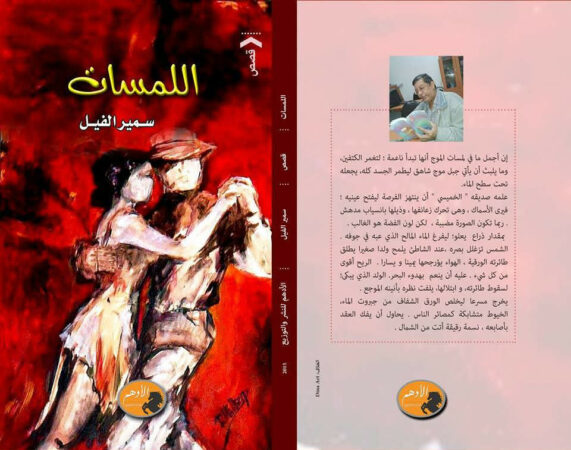
بعيداً عن الأدب، ما هي الهوايات أو الاهتمامات التي تشغل وقت سمير الفيل وتمنح روحه طاقة جديدة للكتابة؟
أسقي النباتات في أصص البلكونة مع طلوع شمس يوم جديد، وأنظر من النافذة على “السائرين نياماً”. أهتم بزيارات متكررة للبحر على مبعدة 15 كيلومتراً من مدينتي. أجلس كل يوم، ما عدا نوبات المرض، في مقهى شعبي ومعي كتّاب من مختلف الأجيال، نتحدث في الآداب، ونقرأ فصولاً من نيكوس كازنتزاكيس أو ديستوفيسكي أو ألبير كامي. أحياناً يجلس معنا مترجم شاب عن الفارسية هو الدكتور يوسف بدر ليقرأ لنا قصصاً للإيراني مصطفى مستور. نحن لسنا بمعزل عن العالم، نتعلم من كتاب سبقونا في الشرق والغرب، في مقدمتهم العظيم نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وبهاء طاهر، كما أكن احتراماً كبيراً لصبري موسى وعبد الفتاح الجمل ولطيفة الزيات (الثلاثة من محافظتي دمياط).
ماذا تقول للكتاب الشباب؟
لا أجيد النصائح، سأتحدث بصوت عالٍ: القراءة مهمة جداً؛ قراءة في التاريخ والجغرافيا والأديان المقارنة، قراءة في الفلسفة وعلم النفس وأصول التربية.
عدم اللجوء إلى النشر إلا بعد مرور فترة من الزمن، تجعلك قادراً على الحكم على منتجك، ويمكن أن تستعين بأصحاب الخبرة. أيضاً، من المهم أن تتابع أبناء جيلك، لتتعرف على إنتاجهم. تردد دائماً على دور المسرح، وقاعات الموسيقى، ومعارض الفن التشكيلي (هذا أمر صعب في الأقاليم)، وتشاهد الأفلام فهي تمنحك طاقة نور. كما أنه منذ بداياتي في أواخر الستينيات،؛ فقد كنت أزور المتحف المصري بالتحرير، حيث التماثيل وأوراق البردي ولوحات تكشف مظاهر الحياة في مصر القديمة، كما زرت متاحف النوبة والواحات.الجيل الجديد من الكتاب أمامه فرصة نادرة للتجاوز، والتخطي، والكتابة الفريدة على غير منوال سابق.